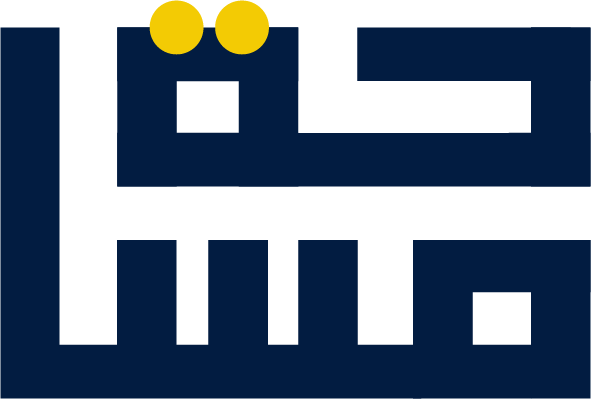صناعة الخطاب الديني المتشدد

يستند الخطاب الدينيّ إلى مصادر التشريع الإسلامي، وهي القرآن الكريم، والسنة النبويّة، ومصادر التشريع الإسلامية الأخرى، سواءً أكان هذا الخطاب صادرًا عن مؤسسة دعوية رسمية أو غير رسمية. المأمول من الخطاب الديني هو التشجيع على الفهم السليم والعقلاني للدين، وتحرير عقل المتديّن من الأوهام، وإبعاده عن السلوك السيء، وإضفاء معانٍ نبيلة ومقدّسة على الصفات الإنسانية العظيمة. لكن مع ازدياد النزاعات والحروب في بلدان عدّة وبروز جماعات إسلامية راديكالية مثلما حدث في سوريا والعراق، أسهمت تلك الجماعات الراديكالية في تغيير وجهة الخطاب الديني نحو توجيه المستمعين صوب سلوك العنف، بغية تحقيق المآرب التي تسعى إليها، فساهمت الخُطب الدينية للجماعات المتطرّفة في خلق أفراد يحملون صفة التشدّد في دينهم ورأيهم وسلوكهم بصورة مُبالغٍ فيها. تلقي المتدينين لخُطب دينية متشددة تستند في الشرح على مصادر دينية معينة، وبخاصة في تلك المجتمعات التي أُلقت فيها الجماعات الراديكالية خُطبها، حيث بقي الناس لسنوات تحت وطأة خطابٍ دينيّ متشدد. إذ “ليس كلُّ خطابٍ ديني على مستوى واحد من الانضباط بالأصول المنهجية وعلى مستوى واحد من الكفاءة والجَوْدة. فهناك مَنْ اتَّسَمَ خطابُهم بالخرافة، والأحاديث الموضوعة، والقصص الغريبة العجيبة، يريدون بذلك استثارة حماس الناس وإعجابهم بهم والصعود على أكتاف عواطفهم.”
أحكام دينية مسيّجة بتقديس الأشخاص
تتسم الحركات الإسلامية الراديكالية بالعنف والتطرّف، وتحمل مشروعًا سياسيًا وأيديولوجيًا يحتوي عددًا كبيرًا من المفاهيم الرمزية الحيّة في الذاكرة، كـ”الجهاد، والاستشهاد، والفتوحات، وتجديد التجربة النبوية، ووهج مناقب السلف الأول، والتأكيد على نقاء الثقافة السلفية”، فولِد الفكر الإسلامي الراديكالي من منهل الوعي الديني المحاصر بسياجات حصينة، وهي السياجات التي صنعها قسمٌ من علماء الدين المتشددين، والتي حوّطت بها نصوص الدين لغرض وضع أحكام وتأويل النص الديني ضمن ساقيةٍ جريانها منحدر، تجرف كلّ ما يخالفها، وحين تغيب النصوص المقدّسة يأتي الفقهاء بالأحاديث النبويّة لتوسيع دائرة الأحكام وتأويل النص، وفي النهاية يأتي الحكم الفقهي كمكمّل. “إنّ كثيرًا من الأسس التراثية التي تقوم عليها أيديولوجيات الحركات الإسلامية، وتعيد إنتاج مقولاتها جاعلةً منها خلفيّة دينية لمشروعها السياسي، والذي تريد فرضه على الناس بزعم أنّه نابع من النصوص الدينيّة ومنسجم معها؛ يأتي في معظمه من تراثٍ فقهي كتبه بشرٌ معلومون، في سياقات وظروف تاريخية محدّدة. فهذا التراث لا يعدو أن يكون آراء أو اجتهادات تخصُّ أصحابها، وفقًا لفهمهم الخاص للنصوص، أو لأغراض مصلحيّة معيّنة، وبالتالي ليس لها ما يُفترض أنّه للنص الديني من قوّة ملزمة عند المؤمنين به. والأهمّ من ذلك، أنّ جزءًا غير يسير منها لا ينتمي إلى “المدوّنة الفقهية” بل إلى ما يُعرف بالآداب السلطانية.”
يستند الخطاب الدينيّ إلى مصادر التشريع الإسلامي، وهي القرآن الكريم، والسنة النبويّة، ومصادر التشريع الإسلامية الأخرى، سواءً أكان هذا الخطاب صادرًا عن مؤسسة دعوية رسمية أو غير رسمية.
استطاع بعض الفقهاء أن يضمنوا قوة وسلطة أحكامهم على المتدينين، وبذلك بدأت قداسة الأشخاص الفقهاء ترتفع مكانتها كلما خاضوا في الحديث الديني وأصدروا الأحكام، وهكذا امتد تقديس الأشخاص بموازاة تقديس النص الديني إلى يومنا هذا، إلى درجة قيام الجماعات الإسلامية الراديكالية بمقاتلة الناس الذين يدنّسون أحكام أولئك الفقهاء الذين يعيرون مسألة العنف في أحكامهم اهتمامًا زائدًا، اعتقادًا منهم بأن تلك الأحكام الفقهية على حق والبقية الباقية جميعها على باطل، ما أهَّل تصدُّر بعض الأشخاص إلى المشهد الفقهي ليكونوا حرّاسًا للفكر الديني، فاعتمدت الجماعات الإسلامية الراديكالية أحكام أولئك الفقهاء كشرحٍ رصينٍ للنص المقدّس، وعلى هذا بُني الكثير من الخطابات الدينية التي تضمّنت أحكامًا فقهيةً وأمثلةً لا حصر لها من كلمات فقهاء السلف والحاضر، إذ تؤيد تلك الخطابات الترهيب والعنف في مواقع عدة مستشهدة بكلمات وأحكام أولئك الفقهاء الذين يربطون جزءًا من التاريخ الإسلامي بالحروب والغزوات، في سعيٍ منهم لشرعنة جولاتٍ جديدةٍ من المعارك. وبحسب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، فإن “الدعوة لتقديس التراث الفقهي يؤدي لجمود الفقه الإسلامي الحديث، وهذا ما حدث بالفعل في عصرنا الحديث نتيجة تمسّك البعض بالتقيّد الحرفي لما ورد من فتاوى وأحكام فقهية قديمة كانت تمثّل تجديدًا ومواكبةً لقضاياها في العصر الذي قيلت فيه، ولكنّها لم تَعُد تفيد في مشكلات اليوم.”
من ثم أتبعت خُطب الجماعات الإسلامية الراديكالية فكرة أسيَجة العقل، ووضع المتلقي للخطاب الديني بين خيارين لا ثالث لهما، وتعتبر أحكام ابن تيمية المثل الأعلى لهذه الجماعات التي فرضت على نفسها التقيّد بها، وهو الذي يدعو الناس إلى ثنائية: فإما أن تكون من طالبي الدنيا وملذاتها، أو تكون من طالبي الآخرة وتكون مضحيًّا لأجلها. وبات المتلقي للخطاب الديني المتشدد أسير ثنائيةٍ في الحياة لا يستطيع تجاوزها إلى أطروحاتٍ يؤمن بها.
أسلوب الخطاب الديني المتشدد
سلكَ المتشددون أسلوبين للخطاب، هما الواقعي والافتراضي، إذ يتبنّى الخطاب الواقعي أسلوب الإلقاء المباشر في المساجد، عبر جمهور يشاهد سلوك الخطيب ويستمع وجهًا لوجه إلى خطابه المنمّق لغويًا، أما أسلوب الخطاب الثاني فهو الخطاب الديني الافتراضي عبر المواقع الإلكترونية المتعددة الوسائط، فالخطيب هنا يخاطب جمهور ديني مسلم متباين الثقافة ومنتشر في العديد من الجغرافيات والدول، ويحمل العديد من الهويات القومية والثقافات المجتمعية. يستخدم المتشددون كافة الوسائل في الخطاب الديني الافتراضي بغية الوصول إلى عقول الناس، فتتكامل المادة المكتوبة مع الملفات الصوتية والصور والمقاطع الفيلمية لإيصال أيديولوجيا العنف الديني إلى العقول والقلوب، ما يخلق ضربًا جديدًا من الخطاب الديني، وتفاعلًا عالي الأثر والجاذبية لمضمون الخطاب، وهو أكثر فعاليةً من الخطاب الواقعي من حيث جذب المؤيدين إلى ساحات القتال.
يختزل الخطابان صورة الإسلام في شكلٍ جديد، ويساهمان في تسويق الأيديولوجيا العنفيّة، وتجنيد المزيد من مؤيدي الجماعات الإسلامية الراديكالية. كذلك يفتحان الطريق أمام بروز جماعات أصولية ذات توجهات عنيفة، ويزيد ذلك من التوترات السياسية على نطاق واسع في العالم، وبخاصة في زمن هشاشة المؤسسات، وفي عالم مضغوط بالمعلومات، حيث تتأجج فيه توترات جمّة.
ضرورة تجديد الخطاب الديني
لقد أسهمت مفرزات الحروب التي سعَّرت نارها الخطابات الدينية المتشدّدة في بلدان إسلامية عدّة إلى بروز سمة العنف والتطرّف بشكلٍ أكبر، كما ساهمت الحروب المستندة إلى الانحياز الطائفي في بلدان عدّة إلى تجمّد معاني التعايش السلمي في المجتمع، وسحب مبدأ التسامح الذي كان سائدًا ما بين شرائحه، وهو أمرٌ لا شكَّ خطيرٌ على مستقبل المجتمعات عامةً، وخاصةً المجتمعات التي عانت من آثار الصراع مع الجماعات الدينية الراديكالية، ما يستدعي إعلاء قيمة التسامح والتعايش من جديد، وبثِّه من خلال الخطاب الديني المعتدل. “ويرى كثيرون أن عملية تنقيح الخطاب الديني في الدول الإسلامية لتجديده هو ضرورة حتمية خاصةً بعدما تسببت بعض المفاهيم الدينية في كوارث عديدة منها كارثة الإرهاب وكارثة إهدار حقوق المرأة واستخدام العنف داخل المجتمع لفرض أفكار معيّنة عليه، وغير ذلك من الكوارث التي تولّدت من رَحِم المفاهيم الدينية التقليدية والتي يتمّ تدريسها على أنها هي الدين.”

لقد أسهمت مفرزات الحروب التي سعَّرت نارها الخطابات الدينية المتشدّدة في بلدان إسلامية عدّة إلى بروز سمة العنف والتطرّف بشكلٍ أكبر.

لذا بات من الضرورة إحداثُ تغييرٍ في مضمون وأسلوب الخطاب الديني التقليدي القائم على مخاطبة عواطف الناس، والاهتمام بمخاطبة العقل، والتعامل مع قضايا الواقع ومشكلاته بدلًا من السرد الدائم لأفكار نظريّة تعتمد على القصص والحكايات القديمة، والتخلّي عن أسلوب الوعظ المباشر في الخطاب الديني، واتباع أسلوب التنوّع واليسر والوضوح، وذلك بهدف إيصال فكرة التسامح إلى عقول وقلوب الناس، وتبيان الرسالة الدينية بأنها رسالة حضارية تحترم العقل، وتحضُّ على العلم وتعدُّه فريضة، وتحترم حقوق الإنسان، وتقرٌّ بالتنوّع والاختلاف وحق الآخر، وتسعى إلى البناء والتعمير، ويبتعد معها الخطاب الديني عن الإساءة والتجريح والاستفزاز تجاه المذاهب والأديان الأخرى، ولا يثير الخطاب الديني لدى المتلقّين الخصومة أو الرفض تجاه أيٍّ من المواضيع المُلقاة.