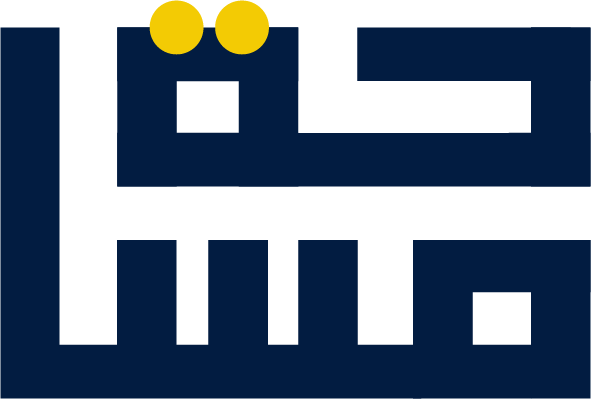التطرّف الديني ودوره في الانقسام الاجتماعي

أحمد الرمح
شكَلت نهاية الستينيات وبداية السبعينيات أخطر حالة مرَّ بها شرقنا البائس، حيث أنتج التحالف الإخواني مع السلفيّة المعاصرة ثقافة القطيعة بين أبناء المجتمع الواحد؛ حين بدأت الصحوة الإسلامية تتولّد نتيجة هذا التحالف وبإرادة دولية، فجاءت ثقافة التكفير ثم التفجير، وليبدأ المجتمع بالانقسام والتشظي نتيجة هذا الفكر الديني المتطرّف الذي يعلنُ القرآن الكريم براءته منه كلّما تلاه قارئ، وتدبّره متدبّر.
فعندما انطلقت الصحوة الإسلامية بعد التحالف المصري-السعودي مطلع السبعينات، كانت نواتها الصلبة حركيًا فلول الإخوان المسلمين الهاربين من سوريا ومصر، وكان دعاتها مشايخ السلفية المعاصرة، لتبدأ ثقافة التكفير حتى غدت ظاهرةً بين أبناء المكوّنات الدينية، ما أنتجَ ظاهرةَ السلفيّة الجهادية التي باركها الرئيس الأمريكي الأسبق “ريغان”، وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية آنذاك “مارغريت تاتشر” من على الحدود الباكستانية-الأفغانية أنّ “قلب العالم الحر يدعمهم في جهادهم ضد الاتحاد السوفييتي.”
سمحت هذه المصلحة الدولية للحكومات العربية بأن تفتح مساجدها ووسائل إعلامها لهذا التحالف الإخواني-السلفي، فظهرت ثقافةٌ نادى بها أعلام ومشايخ الصحوة بتكفير الآخر المختلف عنهم، ليتأسس انقسام اجتماعي ويبدأ السلم الأهلي بالانهيار، فكانت أحداث “جهيمان العتيبي” في الحرم المكي، وأحداث سوريا في الثمانينيات، ناهيك عن دور جماعة التكفير والهجرة ثم الجماعة الإسلامية في مصر، والدور الخطير الذي لعبته في الاغتيالات وقتل الشرطة، والتي انتهت بتفجير السياح هناك، والعشريّة السوداء في الجزائر.
بدأت شرارة هذا التطرّف بعد الانحراف الفاحش في الفكر الإخواني، وتسليم قيادة التنظير في الجماعة لسيد قطب، وهنا ولِد الفكر القطبي الذي يستند إلى الحاكمية كمنطلقٍ لاهوتيٍّ في الوصول إلى الحكم، وتكفير الأنظمة كتبريرٍ لشرعنة فكرة الوصول إلى السلطة، والحكم بجاهلية المجتمع حتى يكون الانقسام الاجتماعي دينيًا طائفيًا.
فكانت الأيديولوجيا القطبية في جاهلية المجتمع، النقطة التي اتكئ عليها الإسلامويون في تبرير تطرّفهم الذي أدى إلى انقسامٍ اجتماعيٍّ حادٍ لم تعرف مجتمعاتنا مثيلًا له في تاريخها. هذا الفكر القطبي الحركي، مع أرثدوكسية سلفيّة حادّة تجاه الآخرين، رسّختها “الوهابية” بسلوكياتها اللاإنسانية؛ كانت البداية في الانقسام الاجتماعي ونهاية السلم الأهلي في شرقنا.
ولِدت فكرة الصحوة الإسلامية نتيجة تحالف أيديولوجيتين، هما الأيديولوجيا السلفيّة المنبعثة بعد طفرة النفط الخليجي، والأيديولوجيا الإخوانية-القطبية المهزومة في مصر، وهما أيديولوجيتان عملتا على سيطرة التطرّف الديني على ثقافة الشارع المتديّن، لدعم الانقسام الاجتماعي، وهو ما أتاح لرموز الإخوان والسلفيّة توجيه الرأي العام المتديّن باتجاه ثقافة القطيعة، وهجر ثقافة المشاركة التي عاشت عليها مجتمعاتنا طويلًا.
وعند محاولة صناعة ثقافة شمولية لمجتمعٍ ما، فالناتج الأول لها انقسامٌ اجتماعيٌّ خطير، والذهاب إلى مرحلة مفتوحة من الصراع، فالاتحاد السوفييتي بجبروته ونتيجة إصراره على الشمولية بالقوة، انهار من الداخل قبل أن يكون الخارج فاعلًا في انهياره وتفككه، والصين انقسمت نتيجة ثقافة شمولية في عصر الزعيم “ماو” إلى الصين وتايوان، وهي تعاني اليوم من أزمة هونغ كونغ والإيغور، وكوريا الشمالية والجنوبية، وليس بعيدًا فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، وأما كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ فقد نجت من الثقافة الشمولية المنحوتة بالفأس والمنجل.
إن إعادة تربية الفرد هي جزءٌ أصيلٌ من مكوّن الثقافة الإخوانية-السلفيّة، لذلك بقي هاجس الإخوان المسلمين الأول هو ميدان التعليم، حيث لعبوا دورًا مهمًا في هذا الميدان بالسعودية أيام الصحوة الإسلامية، خصوصًا بعد السياسة التعليمية التي أُقرّت في المملكة منذ عام 1970.
فالتعليم الديني لدى الإخوان يتجاوز فكرة الإرشاد والتوجيه المعروفة إلى ثقافةٍ تقوم على قاعدة تغيير ثقافة مجتمع، وإحلال ثقافة بديلة أكثر منها ثقافة دينية تقليدية، وبالتالي كانت حقبة الصحوة عبارة عن عملية تغيير شاملة لإعادة إنتاج مجتمع جديد، فوقعت الانقسامات الاجتماعية في شرقنا.
فالصحوة الإسلامية لم تأت كظاهرة محفِّزة للنشاط المجتمعي باختلافه، ولم تأت للانقلاب على الواقع بغية تجديده بواقع أفضل، بل كانت البداية بقصد استهداف الأجيال الشابة الجديدة عبر بثِّ ثقافة التطرّف الديني.
بدأ النشاط المتطرّف مطلع الصحوة الإسلامية مستغلًّا ظاهرة “شريط الكاسيت” ليقدّم محاضرات دينية وصلت إلى شرائح المجتمع المختلفة بسهولة، وكان ذلك عملًا منظّمًا عمم ثقافة القطيعة والانقسام الاجتماعي على أساس مذهبي/طائفي، ليقنعَ المسلمَ البسيط بأنه مقصِّرٌ تجاه دينه، وبالتالي عليه أن يجدَّ في الإخلاص لهذا الدين، ولا بُدَّ من مقياس لهذا الإخلاص يتمثّل في التضحية، فجاءت فكرة الإنسان القربان الذي يضحّي بنفسه من أجل الأيديولوجيا حتى ولو بقتل الآخرين، وساهم “الكاسيت الإسلامي” ببثِّ ثقافة الحوريات اللاتي ينتظرن “المجاهد” في الجنة نتيجة هذا العمل الإرهابي، ليتمتَّع بهنَّ جنسيًا كمكافأةً لتضحيته بنفسه وقتل الآخر المختلف عنه.
إن أخطر ما أفرزته الصحوة هو محاولة أسلمة جيلٍ مسلمٍ أصلًا، وانتزاعه من وسط المجتمع، ودفعه لتقسيم المجتمع إلى مسلمٍ ملتزمٍ وآخر غير ملتزم، ويأتي ذلك وفق أيديولوجيا إخوانية-سلفيّة. وللوصول إلى مقياس يبيّن أثر هذه الثقافة في المجتمع، برزت ظاهرة اللباس الإسلامي، فجاء الحجاب للمرأة بشكله الخليجي مع عباءة تستطيع أن تميّز صاحبتها في المجتمع بسهولة، وترافق ذلك مع مظاهر اللحية والثوب القصير للرجال، والدعوة إلى التزام الجمعة والجماعات، وهذه مظاهر شكلية كانت تستخدمها الجماعات المتطرّفة لقياس مدى تأثير خطابها وأيديولوجيتها في المجتمع.
بعد ذلك جاءت مرحلة إنشاء تنظيمات سرّية إسلاموية بين الشباب المتديّن. كانت الحاكمية الإلهية التي ابتدعها “المودودي” في الهند، وعَرَّبها سيد قطب هي الباعث الحقيقي للتنظيمات الإسلاموية التي اعتمدت الإفراط في العنف، فكانت آخر تجلياتها الدينية متمثّلة في جبهة النصرة التي سقطت عنها ورقة التوت في إدلب والمناطق التي تحتلّها، من خلال ممارساتٍ يَبْرَأُ منها الإسلام، وسلوكيات منحرفة جعلت الشارع الثوري يكفر بانتفاضته، ثم يأتي التجلّي المتوّحش الذي مثّلته “داعش” ومارست من خلال إرهابها تطرّفًا لاإنسانيًا، لتنسبه زورًا وبهتانًا إلى الإسلام الحنيف.
لقد أسَّس التطرّف الديني إلى جانب ذلك كلّه ثقافةً أخرى تساهم بالانقسام الاجتماعي، تمثّلت في تحريم ثقافة اللهو والمرح والكوميديا، واستبدلت بها ثقافة البكاء والعويل خوفًا من الموت وعذاب القبر، وبالتالي تم تحريم الموسيقا والغناء والتمثيل، لتستبدل بها أناشيد ومرويات ومواعظ الفوز بالجنة والنجاة من عذاب جهنم.
ثم جاءت فكرة توسيع الانقسام من المجتمع إلى العالم، وجاء الفكر القطبي الجهادي من خلال زعيم السلفية الجهادية، أسامة بن لادن، ليقسِّم العالم إلى فسطاطين: فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، وهذه الفكرة ليست إلا عولمة الانقسام الاجتماعي، ليغدو انقسامًا عالميًا!
وحتى لا تكون هناك نافذة نور لإنقاذ مجتمعاتنا، لا بُدَّ من هجومٍ عنيفٍ على التنوير الديني ودعاته، فكانت موجة تكفير أعلام التنوير التي لم يَنجُ منها حتى الموتى، فكفّرت القطبية-السلفيّة علي عبد الرازق وطه حسين والعقاد وغيرهم، لتتجلّى حربها الشعواء على التنوير من خلال إطلاق فتاوى بتكفير نجيب محفوظ ومحاولة اغتياله، ثم بتكفير فرج فودة واغتياله، وصولًا إلى تكفير نصر حامد أبو زيد والحكم عليه بالردّة. وبظهور أعلام جدد للتنوير مع وجود الإعلام الفضائي، تم تكفير محمد شحرور الذي ضرب بنيانهم المتطرّف بمقتل، وتكفير الطالبي بتونس وغيرهم كثيرون، حتى قال سفر الحوالي، وهو أحد كهنة التطرّف، إن “التنويريين العرب هم أخطر أعداء الإسلام!”
ونتيجة ضخِّ ثقافة التطرّف، استغلّت الجماعات المتطرّفة الربيع العربي لتسطو عليه وتسرقه، حتى حوّلته إلى شتاءٍ قارس، وعشريّةٍ سوداء، ليتجلّى بذلك الانقسام الاجتماعي تحت ذرائع متعددة على رأسها ثقافة الطائفية والقوموية الشوفونية؛ وتكفير الآخرين، وكان التجلّي الداعشي أحد أبشع مظاهر هذا التطرّف.
ختامًا، إن نقد التطرّف وتعريته؛ تبرأةٌ للدين منه. وإنّ الوقوف مع التطرّف بأيِّ شكلٍ من الأشكال؛ إساءةٌ للدين. فرسالات السماء دعوةٌ للمحبة والسلام والإيمان، لا دعوة للتطرّف والتكفير والتفجير.