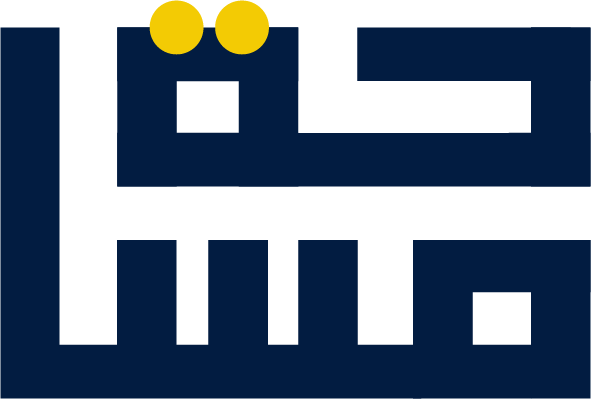التطرّف الديني ودوره في التأسيس للعنف القائم على النوع الاجتماعي

يُولَدُ الإنسانُ غير مزوَّدٍ ببنية فكرية تحدد هويته الدينية وانتماءاته الطائفية، فمورثاته لا تحتوي على اسم الدين الذي سينتمي إليه بحكم الضرورة، لكنه ورغم ذلك يجد نفسه مقيداً بدينٍ محدد، ومطلوب منه منذ الولادة أن يكون مسؤولًا عن شيءٍ لم يقم باختياره أصلًا.
في واقعٍ كهذا، يبدو انتماء أيِّ أحدٍ فينا لدين أبويه أمرًا بسيطًا، ويمكن ألا يتسبب هذا بمشكلةٍ تؤثِّر في حياةِ أيٍّ منّا، لكنَّ المعضلة الأساسية تبدأ حين يحاول دينٌ ما أن يثبت صحته على حساب باقي الأديان، وهذا للأسف ما تعانيه غالبيةُ الأديان حول العالم، إن لم يكن جميعها.
من ناحيةٍ أخرى، يحدّثنا التاريخ عن الأثر الذي تركته الأديان التوحيدية في المجتمع وكيف ساهمت في تغيير الأدوار الاجتماعية، والانتقال من السلطة الأمومية إلى الأبوية، وهي السلطة التي تعززت ضمن التحزّبات والانتماءات الطائفية، فأرجعت الحكم إلى من يقال عنه هو، دون مبررٍ لذكورية اللفظة لمن لا جنس له.
لقد تعلَّمَ المتديّنون جيدًا عبر تاريخهم الطويل كيف يطبّقون أفكارهم التي يؤمنون بها، وازدادت قدرتهم على استخدام كافة الأساليب مهما كانت عنيفة ليؤكدوا أنهم على حق، فقد اكتشف هؤلاء أن أكثر الأساليب نجاحًا هو خلق الخوف في قلوب الجماهير، لأن الخوف المتكوّن في أفئدةِ الناس هو وحده ما سيعززُ الشعورَ بالتفوق لدى من يرغبُ بالسيطرة.
في واقعٍ كهذا، يبدو انتماء أيِّ أحدٍ فينا لدين أبويه أمرًا بسيطًا، ويمكن ألا يتسبب هذا بمشكلةٍ تؤثِّر في حياةِ أيٍّ منّا، لكنَّ المعضلة الأساسية تبدأ حين يحاول دينٌ ما أن يثبت صحته على حساب باقي الأديان.
وعمومًا، تظهر رغبة السيطرة لدى الإنسان ضد الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمع، وتتعزز تلك الرغبة بظهور السيطرة الأبوية التي يحميها الدين، فيزداد تطرّف الإنسان وتتعالى قدرته على المغالاة في التشّدد لتأكيد أفكاره التي تخدمه في تحقيق تلك السيطرة، وتتبلور الحلقة الأضعف في المجتمع وهي المرأة، فتوضَعُ قوانين خاصة بما هو مسموح لها ومحظور عليها، وحتى عندما لا يكون هناك قانون، تظهر عادات وتقاليد لتحريكِ النساء كالدمى، وتؤسس لتبعية بدأت منذ قرون وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، فها هي التعاليم التوراتية تصفُ المرأة بأنها عبارة عن دنس ورمز للخطيئةِ الأولى، ولذلك عليها أن تكون مدينةً للذكر طوال حياتها كي تكفِّر عن ذنبها في إخراجه من الجنة.
في هذا الإطار، استمرت هذه الصورة مع سيطرة الكنسية في الدين المسيحي وتعززت في الكثير من المواقع، وكان كلّما اشتد التطرّف لدى المتديّنين ازدادت معه صورة المرأة المسؤولة عن غواية الذكر المؤمن، وقد يبدو ما فعله المتطرّفون المسيحيون بالفيلسوفة “هيباتيا” الإسكندرانية في العام 415 م أكبر دليلٍ على أثر التطرّف الديني في خلق أبشع حالات العنف المبنيّة على النوع الاجتماعي، ويعود هذا إلى القالب الذي وضعه رجال الدين في تلك المرحلة للنساء، إذ لا يحق لهنَّ أن يكنَّ فيلسوفات أو مفكِّرات أو عالمات، فالدور المناطُ بهنَّ أن تبقين في المنازل لرعاية أزواجهن وأطفالهن، ومن تفعل غير ذلك وتسعى للعمل الفكري تُسمّى ساحرة، وأي محاولة لتغيير هذا الواقع فإنها ستُعاقبُ أشدَّ عقاب.
وعمومًا، استمرت النظرة الدونيّة للمرأة طوال قرون متعددة، إذ تميّز العصر الحديث بابتكار أساليب جديدة للعنف الديني المبني على النوع الاجتماعي، فالمتدينون لا يرغبون بأن تخرج المرأة وتختلط مع الرجال إلا إن أعطاها الرجل نفسه تلك السماحية، وتخبرنا المراجع والكتب كيف ساهم مفكرون وفلاسفة من عصر التنوير في أوربا بتعزيز صورة المرأة بوصفها مجرد أداةٍ لإرضاء رغبات الذكر، وهذا ما زاد من خطورة الأمر لقرون عديدة، وحوّلَ المرأةَ لأداةٍ في عقد الصفقات التجارية، وفي إرضاء غرائز الذكر الذي يقوم بتوظيفها ضمن أدوارٍ وضعها المجتمع الأبوي وعززها.
تظهر رغبة السيطرة لدى الإنسان ضد الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمع، وتتعزز تلك الرغبة بظهور السيطرة الأبوية التي يحميها الدين، فيزداد تطرّف الإنسان وتتعالى قدرته على المغالاة في التشّدد لتأكيد أفكاره التي تخدمه في تحقيق تلك السيطرة.
في المقابل، قدّم داعش في وقتنا الراهن أشدَّ النماذج الدينية تطرفًا، فخرج عن النص الديني بكافة تفاصيله مبتكراً مفاهيم لا تمتُّ للدين بصلة، وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنه يدلُّ على أن الهدف لدى داعش وأمثاله ليس نشر الدين، وإنما توظيفه لخدمة مصالح تتعلّق بالسيطرة والتمدد، وإثبات القوة وتعزيز المفاهيم التسلّطية المتعلّقة بالنوع الاجتماعي أيضًا، كتزويج القاصرات، وجهاد النكاح الذي لا يمتُّ للإنسانية بصلة، وتحويل المرأة لسلعة تتم المتاجرة بها تحت طائل خدمة المجاهدين، فلكي تكون المرأة صاحبة دين عليها أن تتقبّل الضرب والإهانة تحت مسمّى الإيمان، وإن تعطّرت فهي زانية، وإن حاولت الحصول على حقها في التعليم ستُتَهَمُ بالإلحاد والخروج عن رأي وليّها.
تكمن المشكلة الأساسية في أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يندرج في الأهداف والأيديولوجيات الخاصة بالجماعات المتطرّفة دينيًا، وغالبًا ما تستهدف تلك الأيديولوجيات حقوق المرأة وتقوم باستغلالها جنسيًا من خلال فتاوى يتمُّ تصديرها على لسان رجال الدين، وكمثالٍ على ذلك عمد داعش في العراق وسوريا إلى إنشاء أسواق نخاسة خاصة ببيع آلاف النساء الإيزيديات بغرض استغلالهن جنسيًا بعد قتل آبائهن وأزواجهن وأولادهن، مبررِّاً ذلك بأنه يحقُّ للمجاهد المؤمن أخذ سبيةٍ كافرةٍ كغنيمة حرب.
اليوم أيضًا، وفي كلِّ لحظةٍ وباسم الدين، تحدث انتهاكاتٌ جسيمةٌ بحق المرأة، بدءًا من اتهامها بالتجديف والكفر، مرورًا بمحاولة إقناعها بضرورة تقديم الخدمات الإلهية، وصولًا إلى استغلالها كسبيةٍ تُباعُ في الأسواقِ لاستخدامها في المتعة، وهذا ما فعلته الجماعات الدينية المتطرّفة في نيجيريا، والتي تسمّي نفسها “بوكو حرام”، حين عملت على خطف الفتيات من المدارس لبيعهنَّ في أسواق النخاسة.
مع هذا النوع من التطرّف، تتغيّر أدوار المرأة ضمن مجتمعها، فيقتصر دورها على تحقيق وظيفةٍ واحدةٍ ألا وهي خدمة السلطة الأبوية المتطرّفة، وتستغلُّ السلطة الدينية ذلك بأشكالٍ متعددة، مما يجعل أكثر الأفعال لاأخلاقيةً أمرًا مبررًا تحت طائل الدين، فتُغسَلُ عقول الشابات لتتقبلّنَ فِعلَ ما يتنافى مع حقوقهنّ الإنسانية إما طواعيةً أو قسرًا، تحت مسمّى خدمة الله، فيتحوّل الخطاب الديني إلى وسيلةٍ يتمُّ من خلالها تبرير انتهاكات وفظائع لا يمكن لعاقل أن يتقبّلها.

لا بُدَّ أن نكون قادرين على مواجهة الحقائق قبل كلِّ شيء، فالتطرّف الديني لم يَعُد اليوم مقتصرًا على جماعاتٍ دينيةٍ تستترُ بمسمّياتٍ مختلفة، وإنما باتَ داخلَ كل البيوتِ وبأشكال متعددة.

ورغم المحاولات المستمرة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وحتى الأدباء والمفكرين، تبقى المسألة عالقة، ولا تظهرُ حلولها بشكلٍ واضح، ففي كثير من الأحيان يتمُّ التعامل مع الجهات الدينية المتطرّفة بوصفها شرعيّة إن كانت تخدمُ سلطات بعض البلدان، بينما تُعتَبَرُ فئاتٌ أخرى مجرمة إن كانت لا تقدم تلك الخدمات، وهذا ما يجعل تطبيق القوانين الخاصة بالفئات المتطرّفة متذبذبًا، ويفسحُ المجال أمام التطرّف الديني للتمدد والانتشار، وحتى مع وجود القوانين والاتفاقيات الدولية نجدُ أن اختراقها باتَ متعةً لدى من يرغب في انتهاكها تحت مسمّيات متعددة، فيغدو الخطاب الديني متغيّرًا وفقًا للمصالح.
في النتيجة، لا بُدَّ أن نكون قادرين على مواجهة الحقائق قبل كلِّ شيء، فالتطرّف الديني لم يَعُد اليوم مقتصرًا على جماعاتٍ دينيةٍ تستترُ بمسمّياتٍ مختلفة، وإنما باتَ داخلَ كل البيوتِ وبأشكال متعددة، وأصبح من الضروري أن يتمَّ إيجاد حلول للآثار الكارثية المترتبة عليه، وفي قائمتها العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولكي نستطيع إيجاد الحلول المناسبة، لا بُدَّ لنا من تفكيك المشكلة إلى أجزائها الأساسية، لوضع الخطط التي تتناسب وطبيعة هذه المشكلة، فالتطرّف الديني ليس مجرّد فعلٍ عفويٍ غير مدروس، وإنما هو حصيلة ممارسات تسلّطية ذكورية استمرت طوال قرون عديدة، وتعززت كلّما استطاع المتطرّفون إثبات قدرتهم على السيطرة مستخدمينَ كافة أساليب العنف، ومدعومين لوجستيًا ومعنويًا من قِبل حكوماتٍ وجهاتٍ تهدف لخدمة مصالحها الخاصة، فتقوم بتوظيف مرتزقة متطرّفين وتضخُّ لهم الأموال، وتوفِّر لهم كافة الشروط الملائمة ليتمددوا وينتشروا.
ضمنَ هذا الواقع، يغدو أيّ حلٍ ضربًا من الخيال إن لم يكُ مدعوماً من قبل حكومات قادرة على اتخاذ القرار، وعلى وضع الخطط التي تسهم في تغيير الأيديولوجيا الخاصة بالمجتمعات المتطرّفة.
ويبقى هذا الحلُّ حلمًا للكثيرين ممن يرغبون ببناء مجتمعٍ عادل، ومتوازن، ومنسجم.