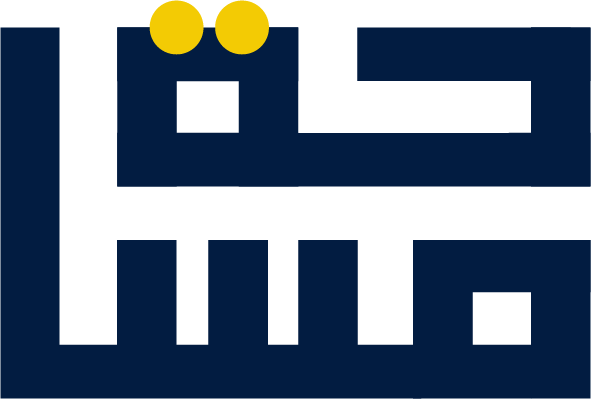الجهاد الافتراضي أو حينما يستحوذ الظلام على الإنترنت

القنص الافتراضي
لقد ولجنا منذ عقود عصرًا جديدًا متّسما بالسرعة على جلّ المستويات التواصلية، وقد ساهم في ذلك الانتشار الموسَّع لشبكة الإنترنت في العالم ككل، إذ بات كوكبنا مغطّى بخيوط هذه الشبكة التي تشدّك إليها بقدر ما تربطك بالآخرين. ومع هذه الثورة المعاصرة، التي تُقاسُ بثورة العجلة والنار والمطبعة، استحالَ العالم “قرية صغيرة” أو “قرية كونية” (Global village)، كما يخبرنا المفكّر الكندي مارشال ماكلوهان. وبالتالي، باتَ في استطاعتنا أن نتواصل بشكلٍ أسرع ونربط علاقاتٍ “عن بعد” مع “أصدقاء” لم يكن في وسعنا التعرّف عليهم أو التواصل معهم قبل هذه “الثورة”، حيث كان العالم يقع خلف الحدود وكان بطيء الحركة. إذًا نحن أمام ثورة “العالم الجديد” و”الإنسان الجديد”، وهي ثورةٌ لا تتوقف عن التطوّر والتقدّم والتغيّر، ولا تفتأ تحسِّنُ نفسها وتصلح أعطابها وتتجاوز ماضيها؛ بل لم يَعُد الماضي يُقاس بالسنوات والعقود بقدر ما يُقاس اليوم بالأيام والساعات، بل حتى بالدقائق (!) أمام التراكم المهول للتقدّم التكنولوجي والمعلوماتي.
لقد بنى ماكلوهان مقولته هذه من خلال ما شاهده من قفزة نوعية وغير مسبوقة نحو الأتمتة وربط الدول والمؤسسات والشركات والأشخاص عبر شبكةٍ واحدة، وهي شبكةٌ غير مرئية لكن خيوطها قوية لا مناص منها. إنها “النظرية الحتمية للتكنولوجيا”، إذ لا مفرَّ من قيودها وأغلالها التي تشدّك إلى أعماق عوالمها. حتمية الإنسان المعاصر، الحسنة التي قادته إلى تطوير الخدمات وتحسينها وتجويدها، لكنها أيضًا آفة العصر حينما تقع بين أيدي “المتطرّفين”؛ تلك الأيادي التي لا ترغب في البناء بقدر ما تسعى إلى الهدم، مدفوعةً بالرغبة في جعل العالم صورةً متشابهة لا اختلاف فيها، وتخدم هذه الأيادي دوغمائية الفكر الواحد والمذهب الواحد والدين الواحد.
لا يفكِّرُ المتطرّف الديني إلا في صناعة عالمٍ يشبهه، ويفكِّر مثله، ويخدم مذهبه الذي يمثّل الحقيقة المطلقة في نظره، لكونه -بحسب زعمه- التجسيد الأمثل لإرادة الله على الأرض، أما باقي الفرق والمذاهب والمعتقدات والأفكار هي ضالة عاصية كافرة وَجَبَ سحقها ومحقها ومحوها من على الأرض، ليظلَّ الكوكب خاليًا إلا من أشباهه؛ من النسخة الواحدة.
لقد مرّت الجهادية من الواقع إلى الافتراضي، من الاستقطاب عبر المساجد التي أُغلِقت في وجوههم بعد الأحداث التي قامت بها “القاعدة” في دول عربية كثيرة، إلى الاستقطاب من خلال شاشات الحاسوب.
يريد المتطرّف أن يخلق “أناسًا من بُعدٍ واحد” -نستعيرُ التعبير من المفكّر الألماني هربرت ماركوز-، حيث المراد هو جعل الكونِ أحاديَّ البعد للفكر والسلوك، يَضعفُ فيه كلٌّ من الاستعداد والقدرة على التفكير النقدي والمعارضة، ويتراجعان في مواجهة هذا المناخ السائد. وإن كان هذا المفكِّر ينتقد النظامين الرأسمالي والشيوعي في كتابه[1]، فالأمر يُقاس على النظام المذهبي واللاهوتي الذي يبتغي المتطرّف تحقيقه في العالم. وقد وجدَ في الإنترنت ضالّته، فهي أرضٌ خصبةٌ لنشر أفكاره المتطرّفة واستقطاب واستدراج “ضحاياه”. ويتحوّل هؤلاء ضحايا بفعل “عمى الإيمان” إلى أيادٍ تخدم مصالح “النظام الظلامي”، أو بالمعنى الآلي إنهم “امتداد” لليد التي تبطش، أو بالأحرى -ونحن نتحدّث عن الشبكة المعلوماتية، وأجهزة الحاسوب التي يتموقع خلفها المتطرّفون، كما يتموقع القناصة في أرض المعركة لاقتناص الضحايا- إنهم امتداد “للإصبع الصغير”[2] الذي يبطش.
إذًا، يقتنصُ المتطرّف ضحاياه، كما يفعل القناص أو الصياد، وهو يراقب ضحاياه بشكلٍ خفي وعلى مهلٍ، يجعل الوقت لصالحه، فيضغط على الزناد/أزرار الحاسوب برويّة حتى تصيب الضحية في “مقتل”؛ أوليس ولوج عالم التطرّف شبيهًا بالموت؟ وإنْ كان قنّاصو الحروب يستعملون رصاصًا حيًّا، فالمتطرّف يستعينُ بكلِّ ما هو افتراضي لاستمالة واستقطاب وقنص الآخرين، لاستدراجهم إلى عرينه. وعلى عكس قناصي الحروب الذين يستهدفون “الرؤوس الكبرى والقوية” في صفوف العدو؛ يسعى الظلامي إلى استهداف “الرؤوس الضعيفة”، إذ يشكِّلُ هؤلاء التائهون وقليلو الحيلة، ضحايا الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة التعليمية الفاشلة أو الواقعين في متاهة الهويّة كما هو حال وشأن أولئك المهندسين والمطوّرين وخريجي الأكاديميات الغربية الذين استقطبهم “داعش” إلى صفوفه، إبان “غزوه” للمنطقة.
الجهادية افتراضية
يهتم الجهادي بالمظهر، فهو الحقيقة عنده، لكونه لا يستطيع الحكم على النوايا وجوهر الفرد، يحتكم إلى مظهره، وبالقدر عينه يحتكم إلى التديّن والممارسة الدينية، لا إلى الدين، هذا الأخير الذي باتَ مجرّد وسيلة لاستعباد الأتباع وبناء مجتمع يوتوبي (مثالي) سريعًا ما يتحوّل إلى ديستوبيا (المدينة الفاسدة). حيث “يتحوّل الإنسان إلى آلة في يد المتدينين، ممن اعتبروا أنفسهم أوصياء على الإنسان، أو على الله أيضًا.”[3] إذ إن التابع هنا مأمورٌ بالانصياع والفعل والقيام بما يؤمَرُ به بلا سؤال أو إعمال للعقل أو التفكير، فكلُّ سؤال هو طريق إلى السوء أو الشك، وكلُّ شكٍ ضلال. ما يقود صاحبه إلى الكفر والنار!
ولأن الظلامي أو المتطرّف يحبُّ دائمًا لعبة الاختفاء، ويعشق المكوث في الظلام لاقتناص ضحاياه، فهو يختار بعناية تلك المواقع الهامشية التي يصعب الوصول إليها ببحثٍ بسيطٍ على محرّك بحث مثل غوغل
على طول تاريخها المظلم، لم تجد الأصوليات قط وسيلةً أفضل من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات نشر المقاطع المرئية (مثل يوتيوب) لنشر خطابها، فعلى مدى ما يقارب 20 سنة أو أكثر، غزت هذه الأنظمة عالم الإنترنت بمظهرها الغرائبي: رجالٌ بجلابيب أفغانية ولحى مسدولة وشوارب تم العفو عنها، ونساءٌ بحجابٍ أسود يغطّي كلَّ أجزاء أجسادهن أو جلَّهُ، وغيرها من المظاهر السطحية التي تريد الترويج للتقشف والعفة والزهد، وهي مظاهر مضلّلة تستهدف نفسية الشباب “الغاضب” من أنظمته الديكتاتورية التي يرى فيها فسادًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بينما العالم اليوتوبي قابع خلف هؤلاء الأصوليين، وما عليه إلا ربط الاتصال بينهم أو السعي إلى حيث يقيمون. هكذا فعلت جلُّ الحركات الدينية المتطرّفة بعد أحداث الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001. انتشرت كالنار في الهشيم عبر المنصات الافتراضية، مستغلّةً ثغرات المراقبة وقِصَر القانون أمام ثورة الإنترنت آنذاك.
لقد مرّت الجهادية من الواقع إلى الافتراضي، من الاستقطاب عبر المساجد التي أُغلِقت في وجوههم بعد الأحداث التي قامت بها “القاعدة” في دول عربية كثيرة، إلى الاستقطاب من خلال شاشات الحاسوب، وذلك عبر كل ما يتيحه الإنترنت وما يرتبط به من شبكات ومنصات ومواقع وإمكانيات افتراضية. وإن كان “كلُّ ما نصطلح عليه اليوم بالجهادية نشأ حال غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، سنة 1979، في جبال هندكوش، ويتحمَّلُ الغرب مسؤوليةً كبرى في الأمر.”[4] فاليوم نشهد نوعًا جديدًا من الجهاد، عابر لكلّ الحدود وغير مرئي وغير ملموس، جهاد معلوماتي-افتراضي لا يحتاج لكثير من التمويل وعديد من الرجال، قد يكفي شخصٌ واحد خلف حاسوبه والكاميرا المهترئة؛ يبثّ فيديوهاته وكلماته التي تخترق عقول وقلوب الشباب الطائش الفاقد للبوصلة والأمل، بقَدر سواء بين المتعلّم والأمّي، وتتحمّل كل الأنظمة السياسية مسؤوليةً كبرى في الأمر.
ولأن الظلامي أو المتطرّف يحبُّ دائمًا لعبة الاختفاء، ويعشق المكوث في الظلام لاقتناص ضحاياه، فهو يختار بعناية تلك المواقع الهامشية التي يصعب الوصول إليها ببحثٍ بسيطٍ على محرّك بحث مثل غوغل، إذ يحوّل موقعه إلى الهامش لقنص وقصف المركز. يعمل المتطرّف كذئبٍ وحيد يخرج ليلًا لاصطياد فرائسه، بالقدر عينه الذي يصعب علينا معرفة هل من رفقاء لهذا الذئب الوحيد، فيصعب أن نجزم هل هناك بالفعل متطرّفٌ وحيد خلف الحاسوب أم أنها شبكة وخلية تشتغل في تناوب وعبر استراتيجيات محددة ودقيقة؟ ويستعصي معرفة مصادر التمويل والدعم اللوجستي الذي يتحصّلون عليه. “إلا أنه وبالرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة التي تلقاها الهجمات الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء، وبالرغم من وقعها المعنوي والنفسي الكبير على المجتمعات المستهدفة، فإن ضررها الفعلي يبقى محدودًا. فما بين عامي 2000 و2013، وقعت في المملكة المتحدة 11 هجمة من هذا النوع أوقعت قتيلين وثلاثة جرحى. وفي الفترة نفسها وقعت هجمتان في فرنسا وقع ضحيتهما ثمانية قتلى وستة جرحى. حيث لا يتعدّى مجموع ضحايا هذا النوع من الهجمات في الغرب للفترة عينها 1,5 % من إجمالي ضحايا الإرهاب عامة.”[5]
بعيدًا عن الإحصاءات وقريبًا من القوة التي باتَ يتخذها الإنترنت في انتشار خطابات التطرّف ويجعله منصات استقطاب، ومواقع تخطيط ودعم ودعاية للفكر الواحد، فمنصة مثل اليوتيوب نموذجًا، تلعب دورًا مهمًّا في نشر فيديوهات الدعوة بلغاتٍ أجنبية، لا بالعربية فحسب، لأفكار الحركات الجهادية، وإن كانت في الغالب من أفراد لم يسبق لهم أن وطؤوا أراضي تلك الجماعات، ولم ينتموا فعليًا إليها، بل تجدهم يقيمون في أماكن تقع أبعد بآلاف الأميال عن “عرين” تلك الحركات. وتُعدُّ هذه الشرائط المصورَّة بديلًا فعّالًا -وفعليًا- عن كلِّ تلك القنوات الفضائية التي تمّ منعها وحظرها، إذ يستقطب متتبعين ومشاهدين أكثر من فئة الشباب والمراهقين، وهم الفئة الأكثر هشاشةً وضعفًا والأسهل في اللعب بمشاعرهم وحالاتهم النفسية، وهم الأكثر حماسًا واندفاعًا، والأكثر ولوجًا لعالم الإنترنت من الفئات العمرية الأخرى.
جهاد النكاح
وتعلّقًا بالحالة النفسية والخطاب المتطرّف، يلعب هذا الأخير على حبلٍ مشدود ورهيف في صفوف الشباب، وهو حبل “الرغبة الجنسية” أو “الكبت الجنسي” الحاصل في بلداننا بسبب القمع الديني والمجتمعي والسياسي، فمن شأن هذا الكبت أن يتحوّل إلى طاقة مكبوتة وجامحة من العنف الذي ينتظر تبريرًا ما ليظهر إلى العلن، ويجد الشاب/الضحية ضالّته في الانتماء إلى الفصائل الإسلامية المتطرّفة التي توهمه أنه سيجد حور عينٍ ليعاشرهن في الجنة بقدرٍ لا نهاية له، ويضعونه أمام صورة فانتازية متخيَّلة لعالمٍ جنّاتي لا يوجد فيه إلا “الجنس”. الأمر شبيه بما يقع على مستوى الجيوش التي تظلُّ معزولةً جنسيًا، ما يثير هيجانًا جنسيًا يخلقُ نوعًا من الاندفاعية العنيفة التي تلغي كلَّ آليات الوعي لصالح الاندفاع الجنسي الذي يتمثّل على شكل العمليات الوحشية والعنيفة، والقتل، بل والاغتصاب والتعذيب في كثيرٍ من الحالات. ليس إيمانًا بالقضية التي يحاربون من أجلها بل إشباعًا لرغباتهم المكبوتة، وهو عينه ما يحدث للشباب المنتمي لتلك الحركات الأصولية. وينعشُ هذا التصوّر تلك الخطابات المصوَّرة أو المكتوبة على مواقع التواصل، والتي تنتشرُ بسلاسة بدون رقيب أو حسيب. فيُجاهد المتطرّف لا لنصرة الدين بل للنكاح والظفر بحورياتٍ أكثر من غيره، ويختلفُ المجاهد هنا عن الجنود الآخرين بأنه مستعدٌّ للتضحية بجسده ليلاقي “نساءه” وينكحهنَّ كما يطيب له، فهو غير مؤمن بصلاحية الجسد، كونه مرتع الفساد والشرور.
وتعلّقًا بالحالة النفسية والخطاب المتطرّف، يلعب هذا الأخير على حبلٍ مشدود ورهيف في صفوف الشباب، وهو حبل “الرغبة الجنسية” أو “الكبت الجنسي” الحاصل في بلداننا بسبب القمع الديني والمجتمعي والسياسي.
ولا يتوقف الجهاد عند العنف والقتل والغزو والحرب والكرِّ والفرّ، فهو مبنيٌّ أيضًا على الخطاب والخَطابة، إذ نجد استعمالًا/خطابًا عن مفهوم الجهاديْن، الأكبر والأصغر؛ الأخير دعوة إلى حمل السلاح في حالات الدفاع ونادرًا الهجوم، بينما الأكبر فيتعلّق بالكيفية التي على المسلم أن يتبعها كي يجاهد بنفسه ليصير مؤمنًا تقيًا، وتنطلق كلُّ الخطابات الإسلاموية من هذا المعطى الأخير، لتخاطب الأفراد على حِدة، كأنها تستهدفهم لبناء الفرد الصالح، لكنها في طياتها تمرر خطابات معادية للمختلفين الذين “لا يشبهون” الصورة التي يرسمونها للمؤمن التقي، والذين علينا أن نقاتلهم “أينما ثقفناهم” (!) فيخلقون بذلك منطقتين منفصلتين في العالم: بلاد الإسلام/بلاد السلم، وبلاد الكفر/بلاد الحرب. إن الجهاد بمعنى “حمل السلاح”، لا دافع له تجاه “الكفار” إلا في حالات قليلة وضرورية، غير أن السلفية الجهادية، ومن تبعها من الحركات الجهادية، كما يمكن تتبعه عبر المنشورات والفيديوهات على الإنترنت، تبحث وتبرر الكيفية التي تفرض بها إيديولوجيتها، فتستعين بالعنف، مبررة إياه بكلِّ آليات التأويل للنص المقدس قرآنًا وحديثًا، لتشرعنه وتقدّسه، وكون هؤلاء الشباب المستهدفين أغلبيتهم قاصرون عن البحث والمعرفة يسهل اللعب بعقولهم عبر ما تستدعيه تقنيات وتأثيرات المونتاج والتركيب في الفيديوهات على المستوى النفسي والذهني.
الخلايا الافتراضية
في السابق، كان يستدعي أمر القيام بعمليات جهادية استقطاب عناصر شابة وتدريبها في أماكن خاصة في بعض الدول (مثل أفغانستان)، أو حتى داخل دول عربية في سنوات التسعينيات بالتحديد، وهو ما كان يتطلّب لوجستيكًا أكبر يستدعي رحلات طويلة بالطائرات وتمويلًا واسعًا للتدرّب على حمل السلاح وغيرها من التدريبات الرياضية والذهنية، بينما اليوم يكفي نشر الفيديوهات حتى يتم غسل الأدمغة التي يسهل استدراجها إلى مناطق الهامش الافتراضي، حيث تترّصد “الأصابع المتطرّفة” الضحايا الجدد لإرسال مخططات واستراتيجيات مبسّطة لكيفية صناعة أسلحة ومتفجرات بسيطة بالإضافة إلى كيفية تنفيذ العمليات في أماكن حساسة، إذ تحوّلت صناعة الخلايا المتطرّفة من فضاءات الواقع إلى الفضاء الافتراضي، أي صناعة الخلايا الافتراضية التي قد يتراوح عددها من شخص إلى عدة أشخاص، بدون أيّ تكلفة تُذكر.
يعتقد المؤمن المتطرّف أنه الوصي الشرعي على الله والعالم، ويؤمن إيمانًا صرفًا لا شك فيه أن ما يؤمن به هو الحقيقة المطلقة لا غير، وقد لعبت أنظمة التعليم من سنوات المرحلة الابتدائية في البلاد العربية دورًا جوهريًا في تعزيز وتغذية هذا “الوهم السلبي”. ويعثرُ الشباب والمراهقون على الخطاب المتطرّف على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تلعب خوارزميات الفيسبوك والإنستغرام، بشكل غير مقصود، على نشر فيديوهات بعض “المشايخ” الرجعيين الذين يغالون في تحريم كلِّ شيء وتقديم فتاوى قابلة للتأويل على أنها شرعنة للعنف ضد كلِّ ما هو حداثي وعلماني ومتحرر ومختلف، إذ ما أن تفتح شريطًا واحدًا حتى تتدفق إلى أصبعك الصغير الذي يحرك الشاشة شرائطَ أخرى ذات صلة. وهكذا يتم الترويج لخطاب ديني يظهرُ على أنه الحقيقة الوحيدة. ومن بين تلك الفيديوهات من يدعو مباشرةً إلى العنف متخذًا دلائله من كتب دينية. وعلى أساسه يتم خلق خلايا افتراضية تتحوّل إلى خلايا على أرض الواقع، من أشخاص لا ينتمون سواء عاطفيًا أو فعليًا إلى حركات أو جماعات دينية متطرّفة معينة. فيتحوّلون إلى آلاتٍ غاضبة ترغب في قتل كلِّ من هو على غير ما تتصوره صورة العالم المثالي الذي يريده الله على الأرض. ولنا هنا أن نحيل إلى أحداثٍ وقعت في أوروبا وحتى داخل العالم العربي، والتي قام بها أشخاص بدهس (فرنسا) وذبح (المغرب) أناس أبرياء، طلبًا للجنة.
يسعى الإرهابي إلى أن ينوب عن الله أينما حلَّ وارتحل، واليوم ونحن نخترق عالم الشبكات الافتراضية التي ينظمها الإنترنت ويربط بينها، نرى هذا المتطرّف المتشبّع بخطابات الكراهية والقتل والتدمير يترصّد المستضعفين والمهمّشين؛ قابعٌ خلف حاسوبه ويضغط على الأزرار وينشر خطاباته المتطرّفة ويدسّها خفية بين ظهرينا، ليصنع مدينته المتخيّلة ولو تطلّب الأمر منه تفجير العالم بأسره. خطته الوحيدة هي محو المختلف، ولأن هذا الفضاء الافتراضي هو مساحة لكلِّ الاختلافات، يجدُ فيه هذا الشخص متَّسعًا للترويج لمعتقداته الهدّامة، مستهدفًا ضعفاء العقل والقلب. لهذا، نحن اليوم في أمسِّ الحاجة إلى إعادة النظر في منظوماتنا التعليمية، وخاصةً الدينية منها، والتي تبدأ من سنوات التعليم الابتدائي، مع العمل على إصلاحٍ ديني ينطلق من نقدٍ ذاتي وتاريخي جوهري، مع تشديد آليات المراقبة في هذا الفضاء المفتوح ضد كلِّ الخطابات الدينية المتطرّفة بل حتَّى ضدَّ أقلّها تطرّفًا.
المصادر:
[1] انظر في هذا الصدد إلى كتاب هربارت ماركوز “الإنسان ذو البعد الواحد”، ترجمة: جورج طرابيشي، منشورات الآداب، بيروت، الطبعة الثانية، 1988.
[2] نستعيرُ التعبيرَ من الفيلسوف ومؤرّخ العلوم، الفرنسي مشيل سير، حيث إننا جميعًا ذلك “الأصبع الصغير”، الذي ينقر على أزرار الحاسوب والهاتف ليلج إلى المعلومة من باب التكنولوجيا والإنترنت، فقد باتت رؤوسنا موضوعة فوق أنامل أصابعنا التي تنقر. أو كما يقول ميشيل سير: فـ”رأس الإصبع الصغير المقطوعة تختلف عن الرؤوس القديمة، المصنوعة جيدًا والمملوءة جيدًا؛ ولأنه لم يَعُد لها أن تشتغل بقوة أكثر؛ لكي تتعلّم المعرفة، ذلك لأن المعرفة أصبحت مطروحة”، فالإصبع الصغير يمشي اليوم حاملًا حاسوبه (رأسه المقطوعة) بين يديه صوب المستقبل.
[3] صلاح بوسريف، آلهة تنوب عن الله، رؤيا للنشر والتوزيع، 2019، ص 70.
[4] Aseim EL DIfraoui, Le Djihadisme, Que sais-je ? coll. puf, 2017, p. 11.
[5] راجع: وسيم نصر، ما هو الدور الحقيقي للإنترنت لمن يستهل طريق الجهاد؟، نشرت في 5 حزيران/يونيو 2014 – 17:04، موقع قناة فرانس 24. france24.com/ar/20140605-الجهاد-أوروبا-إرهاب-الدولة-الإسلامية-الشام