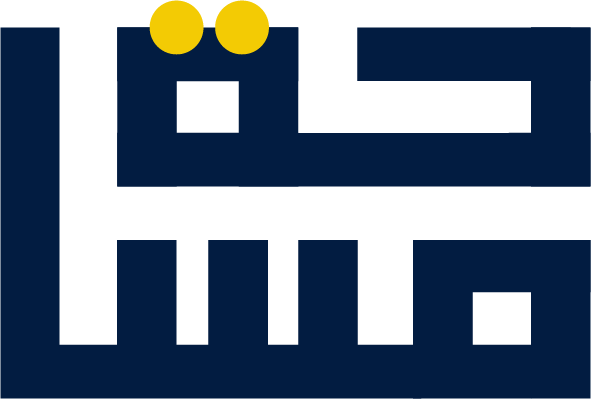الفن والإرهاب.. وجهاً لوجه

- استتيقا الموت:
لقد أدهش تنظيم داعش الإرهابي العالم، ليس بسرعة انتشاره وتوغله في الجغرافيات التي سيطر عليها سريعاً فحسب، بل أيضاً عبر تلك التقنيات والأدوات والمهارات الفنية التصويرية التي تضاهي أفلام هوليود سواءً إخراجياً أو تشخيصياً وحتى حبكةً؛ لكن بدل أن يكون هنالك ممثلون يشخصون الأدوار التي كُتبت لهم، فقد جعل هذا التنظيم الأمر أكثر واقعيةً ودموياً حقاً من خلال جعل “الأبطال” من أعضائه وأفراده، بينما “الأعداء” فهم الأسرى والمخطوفون. لقد صارت العملية التمثيلية أكثر واقعيةً، بل إنها من لحمٍ ودمٍ حقيقييْن، وباتت عملية “القتل” السينمائية عمليةً “ملموسة” وحقيقية؛ مما جعل العملية “الفنية” تتخذُ بُعداً إرهابياً لا استتيقياً.
إننا إذاً أمام “استتيقا الموت”[1]، إذ لمْ تعد الصورة أداةً لخلق الحياة من لحظةٍ مقتنصة في الماضي، بل صارت أيضاً أداةَ خلق الموت من الحياة والموت عينه، ومن هذا المنطلق باتت تلعب اليوم الصور عبر التلفاز والأنترنت سنداً قوياً ”للإرهابي” لتمرير ”صور الموت” عبر شكلٍ جماليٍّ مُبهِر، مستعملاً في ذلك أدوات ومؤثرات بصرية عالية الجودة، تُبهر وتُفْتِن الناظرين وتخدعهم؛ الافتتان هنا كما يقول ج. كوهن في مؤلفه (الحركة على الإنسان I’action sur I’homme)، هو “قوة الإعلام المرئي، نظراً لوجود الأشخاص المجردين إزاءه من وسائل التبعيد ومن استدراك النظر”، والخداع هنا “هو فقدان المتفرجين لاستقلالهم الذاتي الفكري، وذلك في استسلامهم طوعاً أو كرهاً إلى دينامية الصور الفيلمية، في حالةٍ لا يشارك فيها الفكر”[2].
لمْ تعد الصورة أداةً لخلق الحياة من لحظةٍ مقتنصة في الماضي، بل صارت أيضاً أداةَ خلق الموت من الحياة والموت عينه.
فبعدما كانت خطب وفتاوى التيارات المتشددة تصبُّ في تحريم الصورة[3] واعتبارها “رجساً من عمل الشيطان”، صارت أداةً “محللة” وفعَّالة في يد “الإرهابـ(ي)”؛ فقد امتلك المتطرفون إذاً “الصورة” ومعها امتلكوا شيئاً من “الفن” ليس لصالح الإنسانية لكن لخدمة مصالحهم عبر طرق البروباغاندا بشكلٍ احترافي؛ ما دفع المفكر الراحل سلامة كيلة إلى القول بأنَّ: “مَن يُصوِّرُ كل ما تعمّمه داعش هو من إنتاج شركة عالمية، وليست من نتاج “جهاديين” على الإطلاق، إن شركةً عالميةً خبيرة هي التي تصوِّر فيلماً يمكن أن يُطلَق تحت اسم “داعش”، ليست قدرات “الجهاديين” على هذا المستوى من التصوير…‘‘[4]؛ لعل مفكرنا لم ينتبه إلى نقطةٍ هامة ومهمة في تاريخ المنظمات الجهادية، التي حوّلت استقطابها للمقاتلين والأعضاء من البلدان العربية ومن المهمشين والمستضعفين إلى استدراج أفراد من البلدان الغربية يمتلكون تكويناً عالياً في معاهد مختصة ومتطورة، من بينها معاهد “السمعي البصري” له خبرة في الإخراج والمونتاج والتركيب وغيره، وقد بدأ التمهيد للأمر منذ ما سمّي ب”عالمية الجهاد”[5] في منعطف العقد الأخير من القرن الماضي مع تنظيم القاعدة[6]؛ فلم تعد هذه الحركات والتنظيمات إذاً في “خصامٍ مع الصورة” مادامت تخدم مصالحها، إذ تحولت من المحرم إلى المكروه المحلل استعماله أو حسب قول ابن باز: “التصوير منكر وممنوع إلا إذا دعت إليه الضرورة فالإنسان يعتبر حينئذٍ في حال الضرورة كالمكره”؛ أو بتعبير آخر مادام في خدمة “استتيقا الموت”.
- الفن في مواجهة الموت:
لقد شغل موضوع الموت بال وتفكير الفنانين على مرِّ العصور، بل قد كان أحد أهم الموضوعات وأكثرها تداولاً واشتغالاً؛ مما سيدفع بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش إلى القول في جداريته الخالدة: “هزمتكَ يا موتُ الفنون جميعها”، هي إذاً علاقة صراع بين غالب ومغلوب تلك التي تجمع بين الفن والموت، بين الساعي إلى الخلود وبين بوابةِ الفناء[7]، لهذا يخبرنا جيل دولوز بأنه يوجد نوع من ’’التأكيد الأساسي بين العمل الفني وفعل المقاومة‘‘[8]؛ لكن أي نوع من المقاومة؟ يجيب قائلًا:’’مقاومة الموت‘‘، من هذا المنطلق قد انبرى مجموعة من الفنانين العرب، وتحت طائلة الغزو “الإرهابي” العابر للقارات لبلداننا العربية إلى الاشتغال على أعمال وموضوعات تسعى إلى مكافحة ومقاومة هذا المدّ الظلامي، بما أُتيح لهم من ألوان وأفكار وأشكال وأجساد.

إننا إذاً أمام صراع بين قوى متنافرة، لم تكن قطّ متداخلة أو متقاربة، كل طرف في الصراع هو عدوٌّ لدود للآخر.

إننا إذاً أمام صراع بين قوى متنافرة، لم تكن قطّ متداخلة أو متقاربة، كل طرف في الصراع هو عدوٌّ لدود للآخر، واليوم قد استغلت الحركات المتطرفة تقنيات الفن لصالح خطابها و”صورتها”، فهي لا تؤسس هذا الاستغلال على أرضية “فنية” أو إنسانية، بل باعتبار تلك التقنيات والتكنولوجيات مجرد وسائل تخدم مصالحها ودمويتها، لإرهاب وترهيب الآخر المختلف؛ بينما يسعى الفنان إلى بلوغ “الحس الإنساني” الجمالي، وملامسة “الكوني في الإنسان” غير عامد للتفرقة بين الكل؛ رغم الاختلاف العرقي واللغوي والديني.
- فن للسلام:
وتحت رؤية عالمية مشتركة للسلام، اشتغل الفنان المغربي رشيد باخوز، عبر حروفيته الصباغية والإنشائية على موضوع التعايش بين الثقافات والديانات واللغات في محاولةٍ لدرء كل أصوليات التطرف، إذ يجعلنا الأثر الفني عند هذا الفنان وخاصةً عمله التنصيبي الفنيinstallation -بلا عنوان- (في معرض باب الكبير، 2016)، حيث تتدلى أحرفٌ بالعربية واللاتينية والعبرية من على أعوادٍ فوق رماد، وهذا يجعلني أقول أمام تساؤلات عدة متعلقة بأسئلة من قبيل: هل العالم يصير إلى ’’موت الحضارة‘‘ (فوكوياما) أم إلى ’’صراع الحضارات‘‘ (هنتنجتون) أم إلى “الحضارة الإنسانية” (تودوروف)؟ ويميل هذا الفنان إلى الطرح الأخير معتبراً أن المستقبل الإنساني ينحو نحو الحضارة الواحدة، حضارة إنسانية يتعايش فيها كل البشر باختلافاتهم الهوياتية والثقافية واللغوية منشدين السلام.

أما بالنسبة لتنصيبته الفنية “التعالي Transcendance” _التي عرضها في معرضه “بين المرئي واللامرئي” (فيلا الفنون، لدار البيضاء 2018)_ قد اتخذ الحرف (العربي واللاتيني والعبري) فيها أشكالاً لولبية ومتشابكة ليعكس الفنان عبرها دلالات رمزية وجمالية بشكل متعالٍ عن الأرض في الاتجاه الأسمى، إحالةً إلى الترفع عن الصراعات الحضارية المرتبطة بالخطاب اللغوي والهوياتي واللاهوتي، وأما بخصوص الأنستلايشن “ترميم أو فَرَّاكَة” الفنية والفيديو الفني المكمل لها “فراكة 2″، (المعرض ذاته)، فرشيد باخوز يدعو من خلالها إلى ضرورة إعادة النظر في الخطاب اللغوي المتداول في جغرافيتنا العربية ولا سيَّما الممتدة من المحيط إلى الخليج بكل تعدداتها الإثنية واللغوية والدينية (الإسلامية والمسيحية واليهودية)، لهذا كان من الضروري تنظيف الحروف (فركها وغسلها) ونشرها وتجفيفها، تحسيساً بحوار حضاري تفاعلي بين الثقافات. وتجمع الأنستلايشن بين العربية والعبرية واللاتينية في اشتغالٍ جمالي عماده رؤية كونية للتسامح والتعايش، كل ذلك عبر حضور منسجم ومتجانس للأشكال والأحرف التي يتفاعل معها المتلقي/الجمهور ليُشكِّل بها جمله ومفرداته الخاصة داخل قاعة العرض.
فالفن مشروع –بالنسبة له- لتجاوز الميتافيزيقا التي تتعالى على كل إمكانية البقاء قيد الأرض وتقاسمها والتعايش فيها، وذلك بغية القضاء على العدمية؛ يقدم لنا إذاً رشيد باخوز أعمالاً فنية عامرة بالعلامات التي تنفتح على علاماتٍ أخرى في متاهة جمالية ضمن سلسلةٍ لا متناهية من الإحالات التي يسعها الكون الإنساني كلها، رسماً لخريطة كونية تسع كل البشر بمختلف ألسنتهم وثقافاتهم وحضاراتهم وأديانهم؛ مُزيحاً أيّ تصور للصراع أو التصادم، ومنادياً بالتعايش والتسامح والسلام؛ لهذا فالحروفية لديه بقدر ما هي معاصرة من حيث الاشتغال وما تحمله من تعدد القراءات فهي تحمل في طياتها دعوة صريحة ومباشرة للسلام، ومن خلال اشتغاله الجمالي يحاول رشيد باخوز تسريب مواقفه ونظراته ورؤيته للعالم عبر تلك الأعمال التي تصير أرضاً خصبة للتأويل الذي يتعدد وينمو ويتضاعف مثل نبات الجذمور.
- الفن وصراع الهوية:
بينما تندرج الرسائل التي يشتغل عليها الفنان المغربي الفاطمي داخل دائرة موت الإيديولوجية ونهاية الدوغماتية ومواضيع التفكيكية وسؤال الهوية، كما سؤال الوضع الراهن بكل ما يشغل بال المواطن العربي من همومٍ وانشغالاتٍ سياسية ودينية وثقافية، إذ سبق واشتغل على موضوع الربيع العربي في أحد معارضه الفردية، وأيضاً على مواضيع تهتم بالتطرف الديني والصراع الهوياتي العربي/الغربي ونحن/هم، وهو الصراع الذي تتكئ عليه خطابات الحركات الإسلامية المتطرفة إذ يستمد جذوره من ثنائية بلاد الإسلام وبلاد الكفر (بلاد السلام وبلاد الحرب)، إذ نلمس في أغلب أعماله محاولةً لتجاوز هذا التصادم الذي يحاول أن يخبرنا أنه «صراعٌ وهمي» ولابدَّ من تجاوزه نحو «هوية غير متشبثة بالماضي وباقية طي أفكاره»؛ فحينما يأخذ مجموعة من الآيات القرآنية ويضعها في دوائر حديدية مسننة، فليس الغرض منها مساً بالكتاب المقدَّس كما حاول البعض وصف الأمر، بل إنما محاولةً لتمرير رسالة كون أنَّ هذه الآيات وبعد ما طالها من تأويل مُؤَدْلج من قبل الشارحين عبر الزمن (حسب تعدد المذاهب وتطاحنها) قد اكتسبت أنياباً حادة وشروحاتٍ قاتلة، وهو ما ولَّدَ هذا الصراع الذي لابدَّ من تخطّيه؛ إلا أنه لن يتم ذلك إلا عبر حكِّ تلك الأنياب وإزالتها، ويتضح الأمر جلياً في البرفورمونس الذي سبق وقدمه تحت عنوان: (مفارقة بارادوكس)، حيث يقوم بتدوير تلك المسننات.
ورداً على الصراع بين «الأنا العربي و الآخر الغربي» الذي لا تزال تستغله المنظمات الجهادية، قدّم الفنان الفاطمي عرضه الموسوم بـ”إنقاذ مانهاتن (01/ 02/ 03)”، على خلفية ما عرفته مدينة مانهاتن سنة 2001 أو ما اشتهر بأحداث 11 سبتمبر/أيلول التي أججت هذا الصراع وما تلاه من حروب في المشرق، وما خلَّفه من سياساتٍ وثوراتٍ هناك؛ «والمميز في هذه التجربة المتكررة لدى منير الفاطمي –كما يُخبرنا الكاتب طلال قسومي- كونها قُدمت في تصورات مختلفة وكانت المواد الموظفة في طرح العمل هي موطن الاختلاف، حيث سعى الفنان لقراءة هذا الحدث وفقاً لتطورات تفاعل العالم والباحثين معه، محاولاً كشف وتعرية جوهر الأحداث والأفعال التي رافقته، وعلى الرغم من تكراره فإن هذا العمل يحمل الفكرة القائمة ذاتها أساساً على تأويل الواقع وطرحه بأسلوب يرتقي بالحدث إلى مستوى الإبداع»؛ فالفنان قدم عرضه (الإنشائي، الظلّي) عبر وضع مجموعة من الكتب التي رافقت الأحداث وما تلاها، وأيضاً مجموعة من الكتب الدينية الإسلامية من بينها نسختان من القرآن مسلِّطاً الإنارة القوية على الكتب؛ ما يُشكِّل عبر الظلّ برجي مانهاتن والمدينة، وما توظيفه للكتب الدينية إلا إيحاء على الخلفية (التأويلية) التي انطلق منها منفذو تلك الأحداث.
استطاع الفاطمي عبر اشتغال وبحث مخالف للسائد أن يعطي أعماله سمة الدهشة والصدمة، التي يحاول من خلالها التعبير عن أفكاره تجاه «الصراع الوهمي»، وأيضاً وضع سؤال الهوية موضع الكشف محاولاً أن يجدد الرؤية حول السلف والتراث؛ خالقاً بذلك سجالاً جديداً في العلاقة الثنائية الجامعة بين الأثر الفني كفعل في التاريخ والواقع، مُسائلاً الواقع عبر الفعل الإبداعي المنبعث من العصرنة وجوهرها.

- الرقص vs الإرهاب:
بعيداً عن الأعمال التشكيلية، يعمل الفنان السوري الراقص أحمد جودة، على جعل الرقص والجسد سلاحاً في وجه الإرهاب؛ إذ يقومُ فن الرقص على تغليب الجسد على باقي الفنون الأخرى، فالجسد وحده الحاضر باعتباره مفردةً فنية، إن لم نقل أنه عمل فنيّ متكامل، لهذا فحينما يعمد الفنان إلى الرقص باعتباره سلاحاً في مواجهة التطرف، فهو يعمل على سلخ الجسد من خطابات التحريم والتجريم، يحرره من القيود “اللاهوتية” التي تُشيطِنُهُ مقابل الإعلاء من الروح؛ بهذا المعنى فالرقص يُقدِّس المدنَّس (الجسد)، فالخطاب الفقهي الإسلامي يحاول جاهداً وضع أغلال وقواعد للبدن، فأنت لا تمتلك بدناً حراً، إذ أنه في خدمة الجماعة، وكل عملية تحررية تستدعي معاقبة الجسد “نحن أجسادنا”[9]، يخبرنا الفيلسوف الفرنسي ميرلوبونتي: “فحضوري في العالم يبدأ من جسدين بل إنني أتعرف على العالم ويتعرف عليّ من خلال جسدي”؛ لهذا يُعَدُّ الرقص تمرداً على “تعاليم الإسلام” حسب الفقهاء، إذ قنن الدين الجسد وتحكم في مجمل حركاته من الصحو إلى النوم، لهذا فحينما يرقص أحمد جودة فهو يهدد سطوة وسلطة هذا التنظيم وغيره، يهدد وجوده عبر نشر خطاب مرئي فنيّ مفاده “ارقص وتحرر”.

وقد ردَّ التنظيم حينما أجهر في وجه الفنان قائلاً أنَّه: “سيطلق النار على ساقه كي لا يتمكن من الرقص”، ما جعله يضطر إلى الفرار من وطنه سوريا ومدينته دمشق، يفرُّ بجسده سالماً من أجل مواجهةٍ بالفن، مستغلاً لصالحه “سلاح داعش” الجديد (الصور) ولو خارج الوطن، وذلك في رؤيةٍ نيتشوية تقدِّسُ الجسد والرقص معاً؛ إذ الرقص _عنده_ التعبير الناصع عن قوة الإرادة وعن «العود الأبدي»، فيقول على لسان بطل روايته زرادشت: «ما أنا بالمُعَبِّر عن أسمى المعاني بالرموز، إلا عندما أدور راقصاً، لذلك عجزتْ أعضائي عن رسم أروع الرموز بحركاتها، وطمَحْتُ يوماً إلى الرقص متعالياً بفنّي إلى ما وراء السبعِ الطِّباق». وينطلق نيتشه في فلسفة الرقص إلى مفهوم الإرادة الرئيسي لديه، والذي يؤكد على أنْ: «لا إرادة إلا حيث تتجلّى الحياة»، ونلمس هذه الأبعاد النيتشوية في قول أحمد جودة الصّارخ: “إما ترقص أو تموت”!
الرقص إذاً عنده نجاةٌ من الموت ومدعاة للحياة، ولم يواجه أحمد النظام الإرهابي فحسب، بل واجه المجتمع المحافظ المتمثل في أبيه الذي لم يكن يرى في الرقص إلا فناً لا يليق بالرجال؛ بالتالي فهذا الفنان إنما يقاوم التطرف تارةً والرؤية المجتمعية المحافظة تارةً أخرى، وبعد نجاحه بالفرار من بطش تنظيم الدولة والخروج من مخيم اليرموك هارباً إلى أوروبا، استطاع أن يُصالح أباه وأن يُنجز أعمالاً كاليغرافيّة تناصر السلام، فقد رقص الشاب –سنة 2017- في ساحة حقوق الإنسان عند جادة تروكاديرو في العاصمة الفرنسية لإيصال رسالة سلام على أنغام أغنية تمَّ تأليفها خصّيصاً لهذا العرض وأدّتها المغنية سانغا.
- سينماتوغرافيا الإرهاب:
لقد نجح الإرهابي في امتلاك تقنيات السينما، مستغلاً كل التكنولوجيا المتاحة والممكنة لصناعة أفلامه البروباغاندية للدعاية لخطابه واستقطاب المزيد من الشباب المستضعَف الذي يرى في نظامه القوة، عبر التأثر بكل تلك المؤثرات التصويرية والصوتية والإخراجية، لكنه لم يمتلك ناصية الفن، فهذا الأخير يُشكِّل بالنسبة له تهديداً، باعتباره ميتافيزيقيا موازية للميتافيزيقيا التي يؤمن بها؛ وباعتباره أرضاً للخطاب المعادي والمضاد الذي يهدد بقاءه واستمراريته.
الأعمال السينمائية والدرامية والتلفزيونية التي تعتمد على موضوع الإرهاب، تُشكل تهديداً صريحاً لهذه الأنظمة المعادية للحياة.
لهذا فالأعمال السينمائية والدرامية والتلفزيونية التي تعتمد على موضوع الإرهاب، تُشكل تهديداً صريحاً لهذه الأنظمة المعادية للحياة؛ فبقدر ما يعتمد “الإخراج الفيلمي الإرهابي” على المباشرة والتأثير باستعراض القوّة والتخويف والوعيد؛ فالدراما في المجال السينمائي والفني تعتمد على الاشتغال داخل المجال السيكولوجي، أو بمعنى أدقّ السيكودراما (الدراما النفسية) psychodrame؛ حيث يتم تضمين جميع ألعاب المرآة مثل: رؤية وجهك في وجه الآخر ورؤية الآخر في وجه طرف ثالث؛ ما يجعل الدراما النفسية تجربةَ تحرُّرٍ من العدوانية والتوتر والقلق[10]، وبمعنى آخر أداة ووسيلة لمجابهة التطرف والإرهاب.

وقد نجحت أفلام عربية عديدة في خلق جو سيكودرامي يُعرِّي عوالم التطرف ويكشف عن منابعها الاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية، ليضع المتلقي في مواجهة نفسية أمام الشخوص التي تحضر باعتبارها مرآة عاكسة تسمح له في تلبُّس الشخصيات نفسياً، ومن بين هذه الأفلام الفيلم المغربي “يا خيل الله” للمخرج المغربي نبيل عيوش 2012؛ اقتباساً عن رواية “نجوم سيدي مومن” (بالفرنسية) لماحي بينبين حول الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء عام 2003 (16 ماي)، و”سيدي مومن” هو اسم الحي السكني، الصفيحي، الذي خرج من صلبه مجموعة من الشباب الذين نفَّذوا أعمالاً إرهابية مُنتمين للقاعدة؛ ويحكي الفيلم عن قصة أخويْن، الأكبر بائع مخدرات والثاني الأصغر بائع خضار وكيف انقلبت حياتهما بعدما دخل الأخ الأكبر إلى السجن وتأثره بجماعةٍ إرهابية، وكيف سيقود الأمرُ الأخَ الأصغر إلى الإقتداء بأخيه والانضمام إلى المجموعة ومن ثم تنفيذ عمل انتحاري.

ومن جهةٍ أخرى فقد نجحت أفلام عربية أخرى منذ ثمانينيات القرن الماضي، في تناول ظاهرة الإرهاب وتفكيك أصولها ووضع المشاهد أمام دمويتها وعنفها وخطرها على المجتمع، أمثال فيلم “الإرهابي” 1994، “طيور الظلام”1995, و “دم الغزال”2005، و “السفارة في العمارة” 2005، وهي أفلام تناقش موضوعات متعددة مثل مسألة التفخيخ والعمليات الإرهابية والترهيب والعنف والتفرقة في حبكة سيكودرامية متباينة.
- ختاماً الفن سلاحاً:
لا نمتلك إذاً إلا الفن سلاحاً في أيدينا لمواجهة الإرهاب والتطرف والمد الظلامي، الذي بات يتغلغل أكثر فأكثر بيننا، يهددنا مستعملاً تقنيات، ظلَّ الفنانون يحتكرونها لأنفسهم ولأنشطتهم الفنية الخلَّاقة؛ فالإرهابي بات متطوراً أكثر و عصرياً سلاحاً وصورةً، فأدرك دور هذه الأخيرة في تحريك المشاعر واللعب على نفسية المتلقي وجعله ينجذب أكثر للخطاب المروِّج له، وبعدما ظلَّ يُحرِّم ويهاب الصورة، ها هو اليوم يجعلها تخدم مصالحه، ونحن لا نملك إلا أن نشد الحبل بشدة وقوة لجهة الجمال والاستتيقا؛ عبر جعل الفن في خدمة تعرية حقيقة هذه التنظيمات والكشف عن العنف والدمار الذي تُبيّته للعالم أجمع، وكم نحن بحاجةٍ ماسَّة اليوم إلى العودة إلى “استتيقا القبح”، حيث تغدو المعايير “المنبوذة” جمالياً معاييراً لإقامة أعمال فنية تحمل في طياتها تعدد القراءات والتأويلات؛ إذ أن القبح مسألة مركزية في الاستتيقا (علم الجمال)، أو كما يقول فريدريش شليجل Schlegel، “القبيح هو الميزة الغالبة والكلية للطابع، للفرد، للمثير للاهتمام، للبحث الذي لا يَقنع ولا يَرضى بأي جديد، للّاذع، وللمذهل”[11].
وقد عمد الإرهابي إلى خلخلة مفاهيمنا، وهو يُصوِّر القبح ويستعرضه، وينتصر عبره ويستقطب إلى صلبه المزيد من المؤيدين والمتحمسين والأنصار والمنخرطين؛ لهذا قد تجرأ جان بودريار J. Baudrillard على التعبير عن استتيقا تدمير برجي مدينة مانهاتن Manhattan؛ ونحن اليوم علينا أن نعيد تدوير هذا “القبح” لصالحنا فنياً وذلك اعتماداً على السيكودراما، وما تنتجه من مشاعر وأحاسيس في دواخل المتلقي وأيضاً عبر مجابهة الإرهابـ(ي) بالفن جسداً وصورة، والخروج بالفن إلى الشارع.
المصادر والمراجع:
[1] راجع موقع http://re-platform.com/ ، مقال الصورة الجنائزية: استتيقا الموت، عزالدين بوركة، نُشر بتاريخ يناير 13, 2019.
[2] G. Cohen-Seat et P. Fougeyrollas, L’action sur L’homme, Cinéma et T.V. Paris, éd. de Noël, 1961, p 47.
[3] أنظر نموذجا: فتوى “أدلة تحريم الصور”، للإمام ابن باز، على موقع: https://binbaz.org.sa/fatwas
[4] سلامة كيلة، صور الجهاد، من تنظيم القاعدة إلى داعش، منشورات المتوسط-إيطاليا، 2016، ص. 49.
[5] Asiem El Difraoui, Le djihadisme, éd. Que sais-je ?, coll. puf, 2017, p. 19.
[6] راجع كتاب: محمد جليد، الخطاب الغربي حول الإسلام السياسي، منشورات الزمن-المغرب، سلسلة شرفات، أكتوبر 2015, ص. 115-119.
يقول الكاتب: “يرى لاسكيي (مايكل م.) أن الإسلام الحركي في الحالة الفرنسية مرده (…) بكمن في العامل الأول في العولمة، التي ساعدت المسلمين على الولوج إلى المعلومة، حيث أصبح أثر الأئمة ورجال الدين يتعدى الحدود الوطنية إلى آفاق عالمية. كما أصبح هؤلاء قادرين على استغلال الأدوات التقنية والتكنولوجية كالإذاعات والقنوات الفضائية والإنترنت لنشر أفكارهم”. (المصدر نفسه، ص 117).
[7] للمزيد راجع في هذا الصدد: الفنّ والموت: المقاومة، والخلود، والزوال، عز الدين بوركة، تم نشره بتاريخ: 31 مايو 2020. على موقع: https://mana.net/15720
[8] G. Deleuze, Deux régimes de fous, Paris, Éditions de Minuit, 2003, p. 300.
[9] راجع: موريس ميلوبونتي، فينومينولوجيا الإدراك، ترجمة فؤاد شهين، معهد الإنماء العربي، (غير مؤرخ).
[10] من أجل التعمق في هذا المعطى راجع:
Gennie et Paul Lemoine, La Psychodrame, éd. Robert Laffont, paris, 1972.
[11] راجع: إدغار موران، استتيقا الجميل والقبيح، ترجمة وتقديم: عز الدين بوركة، نُشر على موقع: https://mana.net/ بتاريخ: 2 فبراير، 2020.
**تعبِّر الآراء الواردة عن وجهة نظر الكاتب/ة وليس بالضرورة عن رأي مَساحة**