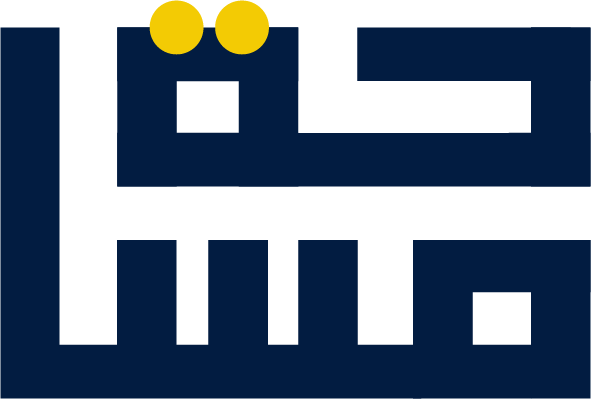المنطلقات النفسية للمنتمين إلى الجماعات الإسلامية ونوازعهم
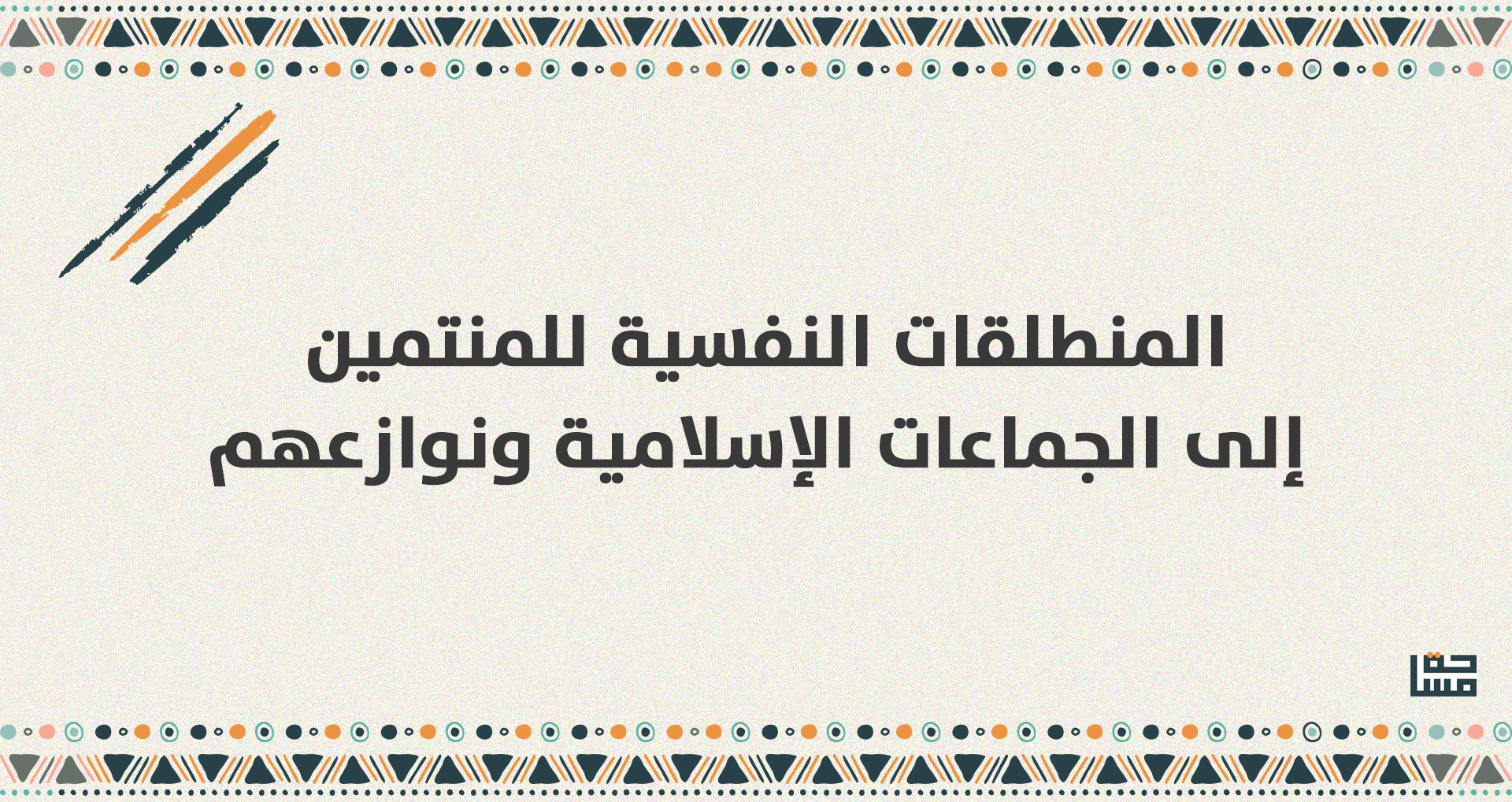
لا يَظهرُ جوهر مشكلة التطرّف في المواقف والسلوكيات العنيفة فحسب، إنما يكمنُ أكثرَ في الطبيعة النرجسية المنغلقة غير المتسامحة وحالة الجمود المترتبة عليها، والتي تقاوم التجديد والتقدّم، ولذلك يحتاج الوقوف على النوازع والمنطلقات النفسية لدى المنتمين للجماعات التكفيرية المرتبطة بالتعصّب العقائدي والعنف الديني إلى عملٍ عقليٍّ متأنٍ.
بحسب أستاذ علم نفس الإبداع، الدكتور شاكر عبد الحميد، يعاني غالبية المتطرّفين والإرهابيين من مشكلات سيكولوجية عميقة؛ “فهم عدوانيون، وجامِحون، وسيكوبائيون (والسيكوبائي شخصٌ متبلّد المشاعر ذو تصرُّفات عَدائية تجاه المجتمع، ومنغلق التفكير، وشديد التصلُّب).” أي إنهم احتاجوا فقط إلى التنظير الإسلاموي وشرعنة نظريّة الجهاد من خلال تأصيل فقهي مُضلِّل مُسْتَقَى من أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب لمنحهم الثقة والاحترام والتبرير لما يمارسونه من أفعال ويطرحونه من أفكار قادمة من عالم السَلَف القديم.
يعاني غالبية المتطرّفين والإرهابيين من مشكلات سيكولوجية عميقة؛ “فهم عدوانيون، وجامِحون، وسيكوبائيون.
نستطيع ضرب أربعة نماذج لأهمِّ منظِّري تلك الجماعات بمختلف مراحلها وتنوّعها من الستينات إلى يومنا هذا ومن الإخوان إلى داعش. إذ نلاحظ إنهم يعانون في الأصل من مشكلة سيكولوجية وعلى إثرها يلجؤون إلى تسييس الدين وشرعنة العنف كترجمة لتلك النوازع المضطربة.
فسيد قطب خريج دار العلوم الذي فشلَ في إحراز مكانة في عالم الأدب وسط جهابذةٍ من أمثال العقاد وطه حسين، وفشل أيضًا في إحراز مكانة سياسية حين رفض جمال عبد الناصر منحه حقيبة المعارف، فقادته شخصيته النرجسية واعتداده الشديد بنفسه إلى البحث عن طريقةٍ للثأر لكرامته المجروحة.
وليثبت “قطب” لمن قلَّل من قدراته أنه متفرّد وأنه صارَ مفكِّرًا كبيرًا وزعيمًا سياسيًا يملك الحقيقة كاملةً ويتبعه الآلاف منقادين ومُوقرِّين، انضمَّ للإخوان وقادَ تنظيمها السريّ المسلّح لقلب نظام الحكم، وصاغَ المنهج الفكري التكفيري الذي صارَ مُلهِمًا لكلِّ الجماعات من بعده.
وحين نستقصي ونتأمّل، نجدُ أن سيد قطب لم يُلهِم منذ الستينات من القرن الماضي إلى اليوم متطرّفين عقائديين متأثرين بتحريفٍ متعمَّد لمقاصد وغايات النصوص الدينية فحسب، بل ألهمَ أيضًا الآلاف من النرجسيين من مختلف الجماعات التكفيرية من الإخوان إلى القاعدة وداعش، وهذا لا يظهر في معاناتهم السيكوبائية الاجتماعية والنفسية وميلهم للانتهاك والاستيلاء على حقوق الآخرين بالقوة وانعدام تعاطفهم مع ضحاياهم فحسب، بل يتجلّى أيضًا في شكل ملابسهم وأغطية رؤوسهم وأعلامهم ورموزهم الخاصة وطرق عيشهم وتعبيراتهم عن أنفسهم من خلال صورٍ يبثّونها على المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً من المنتمين لداعش.

لا يَظهرُ جوهر مشكلة التطرّف في المواقف والسلوكيات العنيفة فحسب، إنما يكمنُ أكثرَ في الطبيعة النرجسية المنغلقة غير المتسامحة وحالة الجمود المترتبة عليها.



يأتي عبدالله عزام في المرتبة الثانية بعد سيد قطب، وذلك في سياق التأثير الهائل في الوسط الجهادي التكفيري؛ فهو من أسسَّ لمنهجية تحشيد الآلاف من الشباب لتركِ أوطانهم والسفر بعيدًا في سبيل خوض القتال تحت رايات تلك الجماعات، وتواصلت تأثيرات كتاباته من دورهِ في تحشيدهم للقتال في أفغانستان إلى ما جرى حديثًا من دفع متطرّفين مسلّحين إلى مختلف الساحات العربية.
لم تكن المشاعر الدينية الغيورة تمثّل الدافع الأول لاندفاع عبدالله عزام نحو تبنّي تلك النظرية التي صاغها في كُتيّبِهِ “الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان”، والتي عارضها حينها الكثير من علماء الدين بسبب تهديدها لاستقرار الدول والمجتمعات وعدم توافقها مع مفاهيم الإسلام الصحيحة، بل كانت أفكاره في المقام الأول مرتبطةً بتأثير حالته النفسية كفلسطينيٍّ عاين النكبة وعاش بلا وطن، ومن ثمَّ فإن استقرار الأوطان والمجتمعات لم يشكِّل أولويةً لديه ولم يضعها في الحسبان.
وإذا تفحّصنا حالةَ من أثَّر فيهم “عزام” ومن تركوا أوطانهم وسافروا ليقاتلوا في ساحات الصراع منذ ثمانينات القرن المنصرم وحتى يومنا هذا، لوقفنا على نماذج ضائعة تشيعُ لديها الحاجة إلى التعويض والانتماء الحميم، وتبحثُ عن فرصٍ لإثبات وجودها في بلادٍ بعيدةٍ، وإلى قوة تحتمي بها وتشعِرها أن لها قيمة بعد أن فشلت تلك النماذج في إثبات أنفسها في أوطانها.
في مصر، وبدايةً من حقبة السبعينات، ظهرَ منظِّرٌ جديدٌ للجهادية بعد إعدام سيد قطب، ذلك هو رفاعي سرور الذي صارَ المُلْهِم الجديد لكل تنظيمات الإرهاب، وباتت مؤلّفاته مرجعيّةً رئيسيّةً لتجنيد الجهاديين الجدد، إذ عَمَدَ إلى تغيير نظرة الشباب للدين، فتحوّلت تعاليم الإسلام لديهم من منطلقاتٍ للسمو القيمي والروحي والأخلاقي إلى وسيلةٍ لتحويل كلّ عدوٍ لأفكارهم عدوًا للإسلام وكلّ خصمٍ سياسيٍّ لهم خصمًا لله ذاته، متوهمين أنهم صاروا شركاء في المعركة بين الحق والباطل، وبين الظلمات والنور، وبين الله والشيطان، وأن المعركة السياسية لتمكين الجماعة من الحكم هي التي ستعيد الشيطان إلى سجنٍ أبديٍّ، وأن الحرب من أجل الحكم والسلطة هي التي ستردُّ آدم إلى الجنة من جديد.
الفكرة الرئيسية لكتاب رفاعي سرور “عندما ترعى الذئاب الغنم”، وهو مادة أساسية لتجنيد الشباب في صفوف الجماعات، تتمثّلُ في أن سبيل الخروج من الفقر والجوع هو خوض المعركة الكبرى ضدَّ ذئاب الأرض التي ترعى أغنام البلد -وفق تعبير “سرور”-، ويعني بهم الحكّام والمجتمعات ومؤسسات الدول، مختزلًا المعركة مع الشيطان في المعركة ضدَّ من يسميهم بالشياطين التي تَحكُمُ الوطن، وليست المعركة التي أرادها الله حقًا ضدَّ الشيطان الذي نعرفه نحن؛ ذاك الشيطان الذي تحدّى الله أمام الملائكة وتسبب في إخراج آدم من جنة الخُلد.
لن يجدَ كادرٌ تنظيميٌّ صعوبةً حينها في إقناع شابٍ صغيرٍ للانضمام لجماعته بزعم أن الله قد اختاره دونًا عن غيره -كما صوَّر لهم رفاعي سرور- ليكون بطلًا في معركة كبيرة ضدَّ الشيطان وذئابه الذين يسرقون البركة من الأوطان لعدم تطبيقهم الشريعة. ومع الاستقصاء نجدُ أنَّ دوافع رفاعي سرور لم تكن عقائديةً بحتة، إنما أيضًا نفسيّة، وذلك بالنظر لشابٍ فقيرٍ جدًا عاشَ البؤس في حيّ “المطريّة” الشعبي ولم يتحصَّل سوى على مؤهلٍ متوسط. وقد وجدَ في احتلال مكانة سيد قطب، كمنظِّر لتلك الجماعات، وسيلةً للصعود ماديًا ومعنويًا بخلق مكانةٍ فكريةٍ وسط حشودٍ من البؤساء الباحثين عن منقذٍ ينتشلهم مما هم فيه.



في مصر، وبدايةً من حقبة السبعينات، ظهرَ منظِّرٌ جديدٌ للجهادية بعد إعدام سيد قطب، ذلك هو رفاعي سرور الذي صارَ المُلْهِم الجديد لكل تنظيمات الإرهاب.



ما فعله “سرور” نفسيٌّ أكثر منه أيديولوجي؛ حيث حوَّل مشاعرَ العزلة والانطواء والتذمّر لدى مئات الشباب من سكان الأحياء الشعبية الفقيرة إلى حالة أيديولوجية متفجّرة تجعلُ الأقارب والأهل والمسؤولين والحكّام أعداءً للدين، وتجعلهم يشعرونَ شعورًا وهميًّا بأنهم أفضل من الجميع دينيًا فيستعلون عليهم، ويظنّون أنهم يحملون السيوف في مواجهة طواغيت الأرض ومستعدون للشهادة لتعلو شريعة الله فوق شريعة البشر.
النموذج الرابع هو عبد الرحمن العلي، وهو أحد أبرز فقهاء العنف الجهادي في داعش وصاحب كتاب “مسائل في فقه الجهاد”، الذي عَمَدَ فيه لتأويل النصوص الدينية تأويلًا شاذًا لتبرير سفك الدماء وجزِّ الرؤوس، وكلُّ ما أوردهُ من آراء مُضلّلة ومنحرفة عن صحيح الدين تعكسُ نفسيّةً مضطربةً نتيجة معاناته وحياته التي قضاها مهاجرًا -كما يصفُ نفسه- بلا استقرار ولا وطن، مُلِهمًا هو الآخر المئات من التائهين والهائمين ممن لا تهمهم صحة ما يعتنقونه من أفكار من عدمه بقدر ما يعنيهم إنهاء ما يعانونه من تشرّدٍ عبر خلق واقعٍ خاصٍ بهم.
حوَّل هؤلاء وغيرهم الدين إلى مكونٍ أساسيٍّ في الصراعات من خلال تحريف تأويلات النصوص الدينية أولًا، وثانيًا عبر استغلال الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الكثيرين ممن يبحثون عن الخلاص من معاناتهم ولو بالكراهية والاستعلاء في الأرض والتمركز حول الذات والجماعة بدلًا من التمركز حول الآخر والوطن والإنسان، وتوظيف الدين في مساراتٍ معاكسة لغاياته ومقاصده الحقيقية.