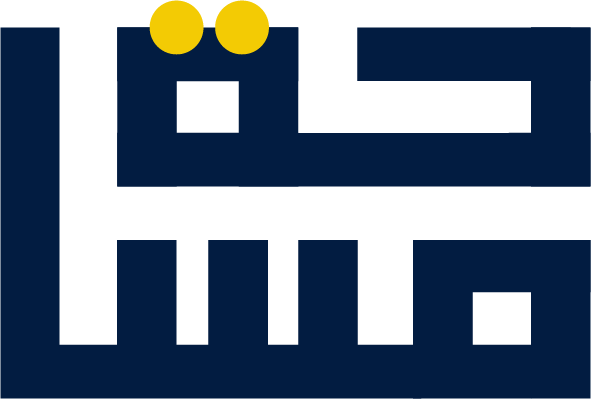خطاب العنف والتطرُّف الديني… هل باتَ ممكناً تفكيكه والحدّ منه؟

تمتلئُ نشراتُ الأخبار، وصفحاتُ المواقعِ الالكترونية وحياتنا اليومية بحوادث عنيفة تتزايدُ كل يوم، وتحملُ تلك الحوادث في طيَّاتها تسمياتٍ مختلفةٍ تُبرِّرُها، كالغضبِ، والكراهيةِ، والخيانةِ، ونشر الدينِ القويم وحتى الحبّ أحياناً.
من شرفاتِ المنازلِ المُطلَّة على إحدى المدراسِ السورية تبدأ الحكاية، فتيةٌ لم تتجاوز أعمارهم العشرَ سنوات، يتجمهرون ضمن مجموعتين متقابلتين، يبدأ القتال بين اثنين منهم بتشجيعٍ ودعمٍ من مجموعتي الجماهير؛ ووسط تحوُّلِ باحةِ المدرسة إلى حلبةِ مصارعة يضحكون كأنهم يلعبون لعبةً ممتعة.
لا يتوقف الأمر عند ألعابِ العنف بين طلبةِ المدارس؛ بل يتعدَّاهُ إلى كنتوناتٍ تُبنى في المجتمع على أساسِ الانتماء الديني والطائفي، وينقسمُ الناسُ ضمنها إلى أحزابٍ تتخاصم فيما بينها دون أيّ سببٍ حقيقي للخصام، فنحن مستعدون لكراهيةِ أشخاصٍ لا نعرفهم؛ فقط لأنهم ينتمون لاتجاهٍ دينيٍّ مختلفٍ عنا، وقادرون على وصمهم بما لا يكونون عليه لأنهم لم يولدوا من الملَّةِ ذاتها.
هل لا زال ممكناً أن نفكك خطاب العنف والتطرُّف الدينيّ؟ وإذا كان ذلك متاحاً فما هي السُبل الحقيقية لذلك؟.
وأيضاً نجد فتاة مراهقة تعاني من مشكلاتٍ نفسية قاسية، تدفعها للانتحار نتيجة تعرُّضها للعنف اللفظيّ لسنواتٍ عديدة ليس من أسرتها القريبة فقط؛ بل من مجتمعها الذي مارس عليها كلَّ صنوف الإساءة.
ضمن هذا الواقع نبدو مُتَّهمين مهما حاولنا، ويتعزَّزُ العنفُ تلقائياً في الخطابِ الرسميّ والمجتمعيّ؛ ذاك الخطاب الذي ينادي للقضاء على اللا عنف بمصطلحاتٍ مليئةٍ بالعنف، كأن تكونَ أقصى محاولات التخفيف من التطرف الدينيّ وممارسة العنف أنْ نضع لوحاتٍ طرقيَّة تُصدِّرُ مقولةً لأحدِ رجالاتِ الدين يقول: لا يجوز للمسلمِ أن يقتلَ أخاه المسلم؛ متناسين كم تحملُ هذه العبارة في سياقٍ آخر عنفاً موجهاً لفئةٍ دون أخرى؛ وبالنتيجة إنَّه عنف.
كل ذلك يضعنا أمام تساؤلاتٍ في غاية الأهمية:
هل لا زال ممكناً أن نفكك خطاب العنف والتطرُّف الدينيّ؟ وإذا كان ذلك متاحاً فما هي السُبل الحقيقية لذلك؟
بعيداً عن العبارات الطنّانة والشعارات غير المدروسة؛ لا بدَّ لنا في البداية أن نتواجه مع حقيقةٍ تبدو قاسية للوهلة الأولى، ولكنها تمثِّل الحقيقة التي ستفسح المجال لنا لتفكيك الخطاب العنفيّ والدينيّ؛ تلك الحقيقة تقول: نحن نسلك سلوك العنف في حياتنا حتى أثناء محاولتنا محاربة هذا السلوك، ونمارس صنوفاً مختلفة من الإساءة لفظياً وأحياناً جسديّاً معبِّرين بأنّه ثمةَ ما يبرِّرُ هذا العنف؛ ذلك العنف ليس وليد اللحظة؛ بل إنه متغلغل في قيمنا الدينية والاجتماعية والسياسية مُذ قَتَل قابيلُ هابيل حسداً وغيرةً، مروراً بالفتوحات الإسلامية والحملات الصليبية ووصولاً إلى العصرِ الحديث الأكثر عنفاً بالحروب الأهلية والانقساماتِ الدينية والسياسية.
انطلاقاً مما سبق يظهرُ أمامنا سبب اختيارنا لفكرةِ تفكيكِ الخطابِ العنفيِّ والمتطرِّفِ بدلاً من هدمهِ كليَّاً؛ إذ أنَّ التفكيكَ يُحاكي عمل التفكيرِ اللا واعي وهذا يُسهمُ في حلِّ بنيان الخطاب السّائد وإعادة ترتيبه وفقاً للنافع والضروري من خلال فهم العلاقة بين النصِّ والمعنى كما يبين الفيلسوف جاك دريدا، ولأنَّ الإنسانَ مسؤولٌ تجاه ذاته؛ يتحتَّم عليه إعمالَ التفكيرِ بالحياةِ ليجدَ حلولاً تُلغي تنميطَ السلوك والأذواق وتعزيزَ أشكالِ الرقابةِ الماديّةِ والرمزيّة من كبتٍ وحجرٍ وزجرٍ وقمعٍ وتعذيب، والتي تُمثِّل قيماً ثقافيةً زائفة وتؤدي لخلق مجرمين ومنحرفين.

يجبُ أنْ يتِمَّ بناء مناهج تربوية وتعليمية لكافةِ الفئات وفقاً لمراحلٍ أوَّلُها دراسة احتياجات الواقع الحقيقي كي لا تكون هذه المناهج غير متناسبة مع الظرف الاجتماعيّ والاقتصاديّ والفكريّ للمجتمع.



ولأنَّ المصطلحات غنية بتعددِ الاستعمالاتِ السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، يبدو من الهام والضروري بدايةً أن نفكِّكَ الخطابَ الموجّه للشّريحة الأساسية في المجتمع وهي شريحةُ الأطفالِ والشباب، من خلالِ اعتمادِ نظامٍ تربويٍّ وتعليميٍّ صحيح يُسهمُ في تفكيكِ الخطابِ العنفيِّ والطائفيِّ إلى مكوناتهِ الأساسيّة بهدفِ استبدالها بمصطلحاتٍ تُعزِّزُ مفاهيماً لا عنفيَّة في التفكير بالدرجة الأولى.
وعليهِ يجبُ أنْ يتِمَّ بناء مناهج تربوية وتعليمية لكافةِ الفئات وفقاً لمراحلٍ أوَّلُها دراسة احتياجات الواقع الحقيقي كي لا تكون هذه المناهج غير متناسبة مع الظرف الاجتماعيّ والاقتصاديّ والفكريّ للمجتمع؛ ولفهم أسباب انتشار ومكونات العنف، وطبيعة التحزُّب الطائفيّ والدينيّ، وهذا يعني ـطبعاًـ بناء فلسفة تربوية جديدة تفكك في مصطلحاتها بنية العنف وتُعيد بناء مصطلحات تعزِّزُ إمكانية الاستمتاع دون ممارسة سلوك العنف، وتتيحُ النجاح دون الاقتتال الذي يُسمى منافسةً في بعض الأحيان، وتُحيلُ المحبةَ إلى سلوكٍ إزاء الآخر بعيداً عن توجهات بيئتهِ الفكريّة والطائفيّة؛ في محاولةٍ لبناءِ وعيٍّ مشترك غير مُنمَّط قوامُهُ المشاركة لا النزاع، وأساسهُ فهم حقيقةَ أنَّ الآخرَ يتألَّم مثلنا، ويعاني كما نعاني، فهو شريكنا بالإنسانية مهما اختلفت أطيافُنا ومذاهبنا.
يترافقُ بناءُ نظامٍ تربويٍّ صحيح مع ضرورة العمل على نشر مستوىً مختلفٍ من الثقافة؛ عن طريق اعتماد الندوات التي تحملُ في طابعها محاكاة الجانب الإنساني لدى الفرد مع ضرورة أنْ لا تتحول هذه الندوات إلى تنميطٍ من نوعٍ جديد، فالهدف هنا ليس السّيطرة على الناس، وإنما إعادة النظر في موضوع الاختلافِ العرقيّ والدينيّ؛ كي لا يشّكل هذا الاختلاف عبئاً يُحوِّلُ الإنسان من خلاله إلى عبدٍ لفكرةٍ محددةٍ دون أخرى، وربما تكون ممارساتُ العنصريةِ في أمريكا خير مثال على ذلك، فرغم التغيّر الواضح في القوانين لا زالت الممارسات العرقية ضد السود مستمرة وبنسبٍ متفاوتة، ولا زالت الممارسات العنيفة ضد الأقليات مستمرةً رغم كلّ المحاولات لتخفيفها والحدِّ منها.
في النتيجة يتبلور هدفنا الأساسي هنا في استبدالِ المفاهيم، فبدلَ أن تكون العلاقةُ مع الآخر عبارة عن صراعٍ مستمرٍ للبقاء، للتفوق، للفوز والسلطة، لربما تصبحُ العلاقة معه مبنيةً على التعاطف والمشاركة والقبول والنجاح المشترك.



يجب على السلطات السياسيّة في المجتمع أن تضع خُططاً تنشر من خلالها ثقافة العمل؛ والتي تعني قدرة الإنسان على إنجاز العمل بوصفهِ جزءاً من كينونتهِ الشخصية.



وليكونَ كل ما سبق ممكناً يجب على السلطات السياسيّة في المجتمع أن تضع خُططاً تنشر من خلالها ثقافة العمل؛ والتي تعني قدرة الإنسان على إنجاز العمل بوصفهِ جزءاً من كينونتهِ الشخصية، فالعملُ ليس مجردَ وسيلةٍ لتأمين مستلزمات الحياة وإنما له دور هامٌّ في بناءِ شخصية الفرد وتحديدِ معالمها. من ناحيةٍ أخرى يُشغل العملُ الإنسانَ عن التفكيرِ في مفرداتٍ سلبيةٍ تُؤثِّرُ في قراراتهِ تجاه الآخر، لا سيَّما عندما يكونُ اختيار العمل مرتبطاً بتحقيق طموحات الإنسان وأحلامه، والمجال الذي يبدع به.
ربما لو فكرنا قليلاً سنعرف أن الإنسان المقابل لي في الحياة، يتنفس الهواء ذاته، وينظر إلى السماء التي أنظر إليها، إنه شريكي في الحياة، فالأطفال لا يكرهون بعضهم ولا يحقدون، والعداوة التي تنشأ بيننا هي من صُنع أصحاب الخطاب السياسيّ والدينيّ والاقتصاديّ؛ ومَن يسيطرون على تفكيرنا الواعي، فهؤلاء يحاولون جاهدين أن يخْلُقوا الفوضى التي تُعزِّز سلطانهم.
في النهاية… إذا أردنا حقاً خَلْقَ حلقةٍ جديدة تمنع انتشار العنف والتطرُّف بكافة أشكاله؛ علينا أنْ نُعيدَ ترتيب الخطاب الثقافيّ والفكريّ والاقتصاديّ؛ على أن تكون الحلقة كاملة لا نقصَ فيها: كتفكيك ثقافة الجيل العنيفة والمتطرِّفة بمناهج مدروسة وصحيحة، نشر مفاهيم ثقافية جديدة تؤكِّد أهمية قبول الآخر الذي يشاركني الحياة، وتأمين فرص عمل متساوية تُتيح المجال للإنسان أنْ يعيش بكرامته دون أنْ يركضَ لاهثاً للبحث عن قوتِ يومه الذي لن يستطيع تأمينه.
**تعبِّر الآراء الواردة عن وجهة نظر الكاتب/ة وليس بالضرورة عن رأي مَساحة**