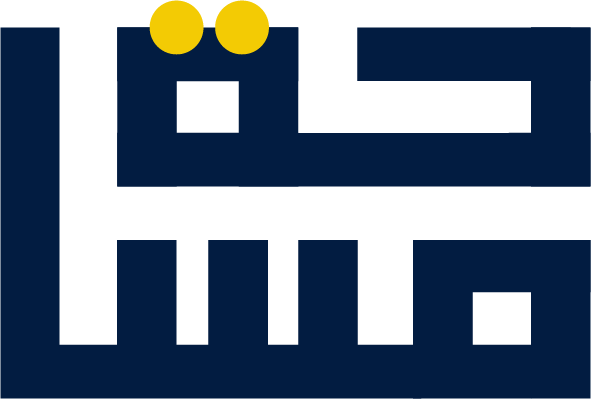“فلاسفة كانوا أم روحانيين”.. التكفير مصير البرهان والعرفان

قبل ثمانية قرون تقريبًا، وصل الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي -وكان صبيًّا- إلى مجلس الفيلسوف والقاضي أبي الوليد بن رشد الحفيد. ذلك الصبي لم يقرأ كتابًا، ولم يدرس على يد الأساتذة. دخلَ خلوته جاهلًا لا يدري شيئًا لكنه خرج منها مُثقلًا بالأعاجيب، مُحمَّلًا بعلومٍ من دون بحثٍ ولا درس، ما أثار اندهاش الفيلسوف وجعله يطلب من صديقه والد الصبي أن يراه.
زاره الصبي الأمرد، الذي لم ينبت شعر لحيته ولا شاربه، فقام له الفيلسوف محبةً وتعظيمًا؛ يريد استكشاف طريقة جديدة للوصول إلى المعارف، حيث دار بينهما حوارٌ رمزي غير مفهوم، فيه يقول القاضي بنغمة السؤال: “نعم؟” فيردُّ عليه الصبي المتصوّف بنغمة الجواب: “نعم.” وتحمل هذه الإجابة نوعًا من التوافق بين الصبي والقاضي الكبير.
هناك طريقتان -في هذه القصة- للوصول إلى المعرفة: الأولى طريقة العقل ويتبناها الفلاسفة والمفكّرون، والثانية طريقة الحدس القلبي والكشف الإلهي ويتبناها المتصوّفة والروحانيون. وعن لحظات التقاطع أو التلاقي بحثَ الكثيرون في تاريخ الفريقين، ففي الأوقات التي تم خلالها رصد مسافات التناغم والانسجام كان هناك فريقٌ آخر تقف على رأسه مدرسة سلفيّة متشددة ومتطرّفة وصلت بـ”الفلاسفة والروحانيين” إلى نهاية الذمِّ والتكفير.
هاجم ابن عربي أصحاب الدليل العقلي، ويقصد المتكلّمين، مستنكرًا استخدامهم “قياس الشاهد على الغائب” في معرفة الله، لأنه ليس بين الباري وبين العالم مناسبة حتى يستقيم القياس لديهم، كما يسخر من متكلّمٍ قاس الله على نفسه ثم قدّسه.
بالعودة إلى اللقاء، الذي نقل تفاصيله المستشرق الإسباني، آسين بلاثيوس، في كتابه “ابن عربي: حياته ومذهبه”، يبدو أن هذه الموافقة الذي أظهرها ابن عربي خلال جوابه أزعجَ ابن رشد أو ربّما أدهشه لدرجةٍ جعلته “ينقبض ويتغيّر لونه”، ويتحوّل للسؤال بطريقةٍ مباشرةٍ بعيدًا عن الرمز، ودار سؤاله حول حقيقة ما يصل إليه الصوفي في خلوته، وهل هو نفس ما أعطاه التفكير العقلي والتأملي للفلاسفة؟ وجاءت إجابة الصبي هذه المرة بنوع من المراوغة، قائلًا: “نعم ولا! وبين نعم ولا تطير الأرواح من مواردها والأعناق من أجسادها!” أي نعم وصلنا إلى ما تصلون إليه، لكن طريقتنا أكثر راحةً وسلامًا للقلب.
تنتهي الزيارة بطلب من ابن رشد لوالد الصبي أن يكررها؛ حتى يتمكّن من عرض المسائل بصورةٍ تفصيليةٍ على الصبي، فيعرف ما وافقه وما خالفه، لكن الزيارة لم تتحقق كما أرادها الفيلسوف. أظهر هذا اللقاء الصغير والمدهش الذي جمع بين قطبين كبيرين، عدم اعتراض ابن رشد على طريقة تحصيل المعارف والوصول للحقيقة من خلال “العرفان” المتمثّل في خلوة المتصوّف، وعلى الجانب الآخر استوعب ابن عربي طريقة العقل والبرهان التي يمثّلها القاضي الفيلسوف.
هذا اللقاء، الذي جمع بين ابن رشد الحفيد المولود في قرطبة عام 520 هجرية/1126 ميلادية والمتوفى في مراكش 595 هجرية/1198 ميلادية، وبين ابن عربي المولود في مدينة مرسية شرق الأندلس عام 560 هجرية/1165 ميلادية والمتوفى في دمشق 638 هجرية/1240 ميلادية، يؤسِّس لعملية التلاقي بين جهود الفيلسوف في تعزيز دور العقل، وبين ترقي المتصوّف الذي يهدف لنشاط الحدس القلبي، لدرجةٍ جعلت الباحثين في حقل الدراسات الفكرية تصف اللقاء بـ”المحور المركزي للدراسات العربية والغربية حول فكر ابن عربي”.
التلاقي بين تجربة العقل والروح
في كتابه “هكذا تكلم ابن عربي”، يرى الدكتور نصر حامد أبو زيد أن هذا اللقاء هو بمنزلة تقابل بين تجربتي الروح والعقل، أو تجربتي العرفان والبرهان، لافتًا بدوره إلى عدة نقاط في غاية الأهمية وهي أن فارق السن بين الصبي والفيلسوف كبير جدًا، كما أن مجيء تلك الرواية في كتاب “الفتوحات المكيّة” يؤكد أن ابن عربي كتبها وهو شيخٌ كبير، أي أنه استدعى ذلك الحدث من ذاكرته “فالذاكرة تعيد تشكيل الحدث من خلال الأسلوب السردي”، إلى جانب انفراد الشيخ برواية اللقاء فلم يذكرهُ أحدٌ غيره.

يقود ابن تيمية مدرسةً سلفيّةً متشددة، تسير على نهجه في النظر للعلاقة التآمرية على الإسلام من ناحية الفلاسفة والمتصوّفة.

يُرجِّح “أبو زيد” أن سؤال ابن رشد عن كيفية الوصول للحقيقة عن طريق الكشف والفيض الإلهي، وعن موافقته للنظر العقلي، تعود جذوره إلى ابن طفيل، أستاذ ابن رشد، الذي اختاره للخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن كي يشرح له “قلق عبارة أرسطو”، فسؤال ابن رشد “ينطلق من خلفيّة فكرية يمكن تلمّس ملامحها فيما كتبه ابن طفيل في رسالته (حي بن يقظان)”، فخلالها “يمهّد ابن طفيل لقارئه أن العقل الإنساني في سعيه المخلص والدؤوب للمعرفة والفهم تحوطه العناية الإلهية وترعاه دائمًا.”
ما سبق، يشرح الجذور الفكرية لسؤال ابن رشد الذي وجّهه للشيخ ابن عربي، حول حقيقة التلاقي بين التجربتين، فيراه متمثّلًا في أستاذه ابن طفيل الذي بحثَ العلاقة نفسها بين العقل والروح في قصته المشهورة “حي بن يقظان”.
ابن عربي.. العرفان تحصيل القلوب
شرحَ ابن عربي تجربة العرفان بمزيد من التفاصيل في كتابه “الفتوحات المكيّة”، وسمّاه بـ”تحصيل القلب” في فصلٍ حملَ عنوان “العلم والعالم والمعلوم”، ووضع ثقته في ذلك العضو لأن “القلب مرآة مصقولة كلّها وجه، لا تصدأ أبدًا”.
ويعلّق على قول النبي: “إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد.” موضِّحًا أن المراد بالصدأ هنا ليس الغشاء الذي يغلِّف القلب وإنما هو “التعلّق بعلم الأسباب”، فالتعلّق بغير الله يُعدُّ صدأً على وجه القلب.
وعن معرفة الله، يؤكد أن إدراكه وتحصيله لا يكون من جهة كسب العقل، ولكن عن طريق جوده وكرمه كما يعرفه العارفون أهل الشهود، والعقل -وفق رؤيته- يستند إلى المحسوس والتجربة والباري تعالى لا يُدرَكُ بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه.
هاجم ابن عربي أصحاب الدليل العقلي، ويقصد المتكلّمين، مستنكرًا استخدامهم “قياس الشاهد على الغائب” في معرفة الله، لأنه ليس بين الباري وبين العالم مناسبة حتى يستقيم القياس لديهم، كما يسخر من متكلّمٍ قاس الله على نفسه ثم قدّسه.
ومن المدهش أن ابن رشد قد هاجم المتكلّمين في معرفة الله من قبل مؤكدًا أن “قياس الشاهد على الغائب” قد أوقعهم في الزلل، وهنا يتفق ابن عربي مع وجهة نظر ابن رشد في نقد تصوّر الكلاميين للذات الإلهية وطريقة معرفتها.
ولم يسلم ابن عربي من الهجوم والتكفير، فقد نُقِلَ عن ابن هشام النحوي المتوفى في منتصف القرن الثامن الهجري أنه هاجم كتاب ابن عربي “فصوص الحكم” قائلًا: “هذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم، كتابٌ يعجز الذام عن وصفه وقد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه.” كما ألَّفَ البقاعي المتوفى في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري، كتابًا أسماه “تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي”.
ابن رشد.. مرحلةٌ فاصلة في دعم العقل
على الجانب الآخر، يبرِزُ ابن رشد طريقته التي تعتمد على القياس العقلي والبرهان، ففي كتابه “فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال” يرى أن الشرعَ دعا المؤمنين إلى تدبّر الموجودات عن طريق العقل، ومن الواجب تعلّم القياس العقلي والاعتبار الذي هو “استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه.”
وصفَ ابن رشد البرهان بأنه أتمُّ أنواع النظر العقلي، ومن الضروري لمن يريد أن يعرف الله وسائر الموجودات أن يتعلّم أنواع البراهين، ويدركَ الفارق بينها، وبما خالفَ القياس البرهاني القياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس المغالطي، ويُسمّى تلك العلوم بـ”منزلة الآلات من العمل.”
ينحاز ابن رشد في فلسفته إلى التاريخ الإنساني المتكامل في وضع العلوم وتطوّرها، ويرى أن كلّ إنسان يحتاج لجهود غيره حتى يتمّ أيّ فنٍّ وأيّ صنعة، لذا كان من المنطقي أن يسمح ابن رشد بمطالعة جهد الأمم الأخرى غير المسلمة، وأن يتعرّف إلى جهود الأفراد مهما كانوا مختلفين عنه، فليس بمقدور إنسانٍ واحدٍ أن يتخلّى عن جهود السابقين ويضع علم الفلك كاملًا من نفسه، وليس بمقدور إنسانٍ واحدٍ “أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظّار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام”، ومن هنا ندرك لما كان الفيلسوف متشوّقًا لمعرفة طريقة ابن عربي في حين أنها تخالف طريقته.
الهجوم على الفلاسفة والمتصوّفة
لم ينجُ ابن رشد وطريقته العقلية من الهجوم أيضًا، ففي كتابه “درء تعارض العقل والنقل”، ذمَّ أحمد بن عبد الحليم الحرّاني المعروف بـ”ابن تيمية”، والمتوفى في منتصف القرن الثامن الهجري، الفلاسفة والمتصوّفة معًا، موضحًا أن أيَّ مدحٍ يصدرُ عن ابن عربي وابن رشد وأمثالهما لأبي حامد الغزالي سوف يكون بسبب أشياءٍ يفارق فيها الغزالي لعلماء المسلمين، أما عندما يذمّونه فذلك في الأشياء التي اعتصم فيها بدين الإسلام واختار ما يوافق الكتاب والسُنّة، وهي طريقة ابن رشد وابن طفيل وابن سبعين، ومن المتصوّفة مؤلِّف “خلع النعلين” -ويقصد ابن قسي- وصاحب “فصوص الحكم” -ويقصد ابن عربي- وأمثالهما ممن يأخذ المعاني الفلسفية ويخرجها في قوالب المكاشفات والمخاطبات الصوفيّة، بينما يسير العوام خلفهم دون أن يعرفوا هل هم يقصدون ما أراده الله ورسوله، أم يقصدون ما أراده الملاحدة كابن سينا وأمثاله، وفق قول ابن تيمية.
التشدد وارتباطه بالخوف من التآمر
يقود ابن تيمية مدرسةً سلفيّةً متشددة، تسير على نهجه في النظر للعلاقة التآمرية على الإسلام من ناحية الفلاسفة والمتصوّفة. هم -بحسب رأيه- يمدحون ما خالف علماء المسلمين، بينما يذمّون ما وافق الكتاب والسُنّة والاعتصام بدين الإسلام، وتلك -وفقًا له- طريقة الملاحدة، وهذا فيما يبدو تكفير واضح للفريقين.
وقد ناقشت الكاتبة التركية، أليف شفق، هذه الرؤية المتعصّبة تجاه الصوّفية والفلاسفة في روايتها “قواعد العشق الأربعون”، ووضّحت مدى تطرّف تلك الفكرة التي تبنّاها ابن تيمية وأتباعه من بعده، وتطوّرها حتى أصبحوا يؤمنون أن هناك تآمرًا وتواطؤًا على الإسلام الصحيح، وخلال فصولها السرديّة أشارت إلى لقاءٍ جمع بين فيلسوف ومتصوّف حدث فيه توافق بينهما، ربما قصدت الشخصية الروائية اللقاء الذي جمع بين ابن عربي وابن رشد في قرطبة.
تقول الكاتبة على لسان إحدى شخصيات الرواية المعروفة بالتعصّب: “الفلاسفة ليسوا بأفضل حالٍ من الصوفيين، فهم يجترّون ويفكّرون وكأن عقولهم المحدودة تستطيع أن تدرك غموض الكون، وهناك قصّة تشير إلى ما بين الفلاسفة والصوفيين من تواطؤ: في أحد الأيام التقى فيلسوف بدرويش، وسرعان ما أصبحا على وئام، وراحا يتحدثان لأيام وأيام، يكمّل أحدهما جملة الآخر.. وأخيرًا، عندما افترقا، قال الفيلسوف عن الحديث الذي دار بينهما: إن كلّ ما أعرفه، يراه.. وأخيرًا قال الصوفي: إن كل ما أراه، يعرفه.. وهكذا فإن الصوفي يعتقد بأنه يرى، ويعتقد الفيلسوف بأنه يعرف، وفي رأيي هم لا يرون شيئًا ولا يعرفون شيئًا.”
والسؤال لدي: لماذا لم يجتمع ابن عربي بابن رشد مرةً ثانيةً طالما حصل اتفاق بين الطرفين انحاز فيه ابن عربي لطريقته القلبية والكشفية؟
في الحقيقة إن ابن رشد رغبَ في لقاء ابن عربي مرةً أخرى، وطلبَ ذلك من والده، لكنّ ذلك لم يحدث، ثم تولّدت الرغبة في قلب ابن عربي لرؤية الفيلسوف، وتحرّك لتحقيق ذلك، لكنّه وجده مُنشغلًا بأحوال الدولة وأمر القضاء، فلم يقع اللقاء بينهما ولم يرهُ ثانيةً حتى مات.
هذا الفشل في اللقاء، يسمّيه ابن عربي في كتابه “الفتوحات المكيّة” نوعًا من الحجاب، ويرى أن المراد أن يمضي كلُّ واحدٍ منهما في طريقة تحصيله، قائلًا: “ضُرِب بيني وبينه فيها حجابٌ رقيقٌ أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعرف مكاني وقد شُغِل بنفسه عني فقلتُ إنه غير مراد لما نحن عليه.”
وفي العام 595 هجرية/1198 ميلادية، يختم الموت لقاءات ابن عربي والقاضي الفيلسوف في مدينة مراكش بالمغرب، وهناك يشهد ابن عربي وفاة ابن رشد، وأنه لما وُضِع تابوته على الدابة لنقل الجثمان إلى قرطبة شمال المتوسط، كان من المطلوب أن يكون ثمة شيء في الجانب الآخر ليعادل التابوت، ولم يجدوا شيئًا أفضل من مؤلفاته وتصانيفه، حتى أصبحت الدابة تحمل تابوتين: الأول لجثمان ابن رشد والثاني لمؤلفاته وكتبه، وفق ما نقله المستشرق الإسباني، آسين بلاثيوس، في كتابه “ابن عربي: حياته ومذهبه”.
لم يسلم ابن عربي من الهجوم والتكفير، فقد نُقِلَ عن ابن هشام النحوي المتوفى في منتصف القرن الثامن الهجري أنه هاجم كتاب ابن عربي “فصوص الحكم”.
ذكر ابن عربي أنه شاهد ذلك الموقف بصحبة الفقيه والأديب أبو الحسن محمد بن جبير وأبو الحكم عمرو بن السراج الناسخ الذي لم يلبث أن شدَّ انتباه صاحبيه قائلًا: “ألا تنظرون إلى مَنْ يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه؟ هذا الإمام وهذه أعماله!” وبدوره يستحسن ابن جبير تلك الملاحظة، ويشيد بمقولة السراج قائلًا: “يا ولدي نِعم ما نظرتَ لا فُضَّ فوك!” بينما يشاهد كلُّ ذلك في صمت الشيخ الأكبر ابن عربي متسائلًا: “هذا الإمام وهذه أعماله يا ليت شعري هل أتت آماله؟!”
فيما بعد، ازدادت ظاهرة الهجوم على الفلاسفة والمتصوّفة من قبل تلاميذ ابن تيمية، لدرجة أنهم لم يستكينوا لإطلاق الفتاوى بل تعدّى إلى تأليف العديد من الكتب التي لا تتواني عن وصف الفريقين بالكفر والخروج عن الدين، الأمر الذي ساعد على انحسار روح التسامح والقيم المكتسبة من جوهر التصوّف، وتراجع دور العقل والقيم المكتسبة من الفلسفة، لصالح التيارات المتشددة والمتنامية.