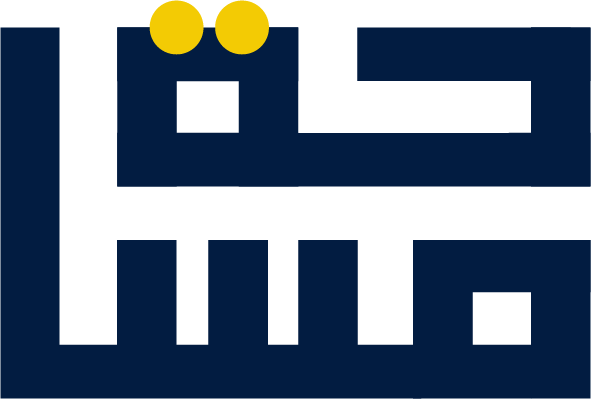قريبًا من شارع الأنقاض

شيرين صالح
فجأةً ارتجت الأرض والجدران، وعمَّ صمتٌ مخيفٌ في الفرن الذي أعمل فيه وسط تسمّر العاملين بأماكنهم. مكان الانفجار غير واضح، لكنه باتجاه شارع عامودا حيث بيتنا بمدينة قامشلي. اتصلتُ عبر هاتفنا الأرضي، كان مشغولاً، اعتقدتُ أن ابني يعبث كعادته بسماعة الهاتف. أخبرني ابن عمتي أن دكاكين كمال القريبة من شارعنا قد تدمّرت بالتفجير، فهرعت إلى البيت بجنون. كان بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٦، كنتُ أرى الجحيم يتجه صوبي كلّما اقتربتُ من شارع بيتنا: زجاجات الأبنية محطّمة، والأدخنة تغطي الأفق. اجتزت الطرق وأنا أتخيّلُ أن بابنا قد خُلِعَ، أو أن جرحًا بسيطًا قد أصاب إصبع ابني. حين التفتُ بالسيارة إلى شارع حيّنا صُعِقت؛ كان كلُّ شيءٍ قد تحوّلَ إلى حطام. بحثتُ عن بيتنا فلم أجده. اعتقدتُ أنني قد أخطأتُ في العنوان. تشابهت كل البيوت في الدمار، وضاعت العناوين في الخراب، وتحوّل مبنانا من ثلاثة طوابق إلى أكوام من الحجارة. كانت أضرارٌ كبيرةٌ قد طالت معظم الأبنية.
كان تفجيرًا انتحاريًا بشاحنة مفخخة؛ شعرتُ أنني أعيش كابوسًا، وانتظرتُ للحظاتٍ كي استيقظ منه، وإذ بابن عمتي يخبرني باكيًا: “نذير! لقد فقدت والدتك حياتها في الانفجار، وهي في مشفى السلام.” لم أصدق وأنا أراها ممددة على السرير، وصرختُ بكلِّ قوتي علّها تسمعني. بكيتُ وحرّكت جسدها الذي كان ما يزال دافئًا علّها تجيبني، لكن بلا جدوى. انعدمت أحاسيسي وصرتُ أتحرّك بشكلٍ لاشعوري. توجّهت برفقة أبناء عمومتي لدفنها، وعدنا إلى مكان التفجير بحثًا عن أبي وزوجتي وابني وأختي وعائلة أخي. وفجأة وقعت عيناي على كومة أحجار كان ينبعث منها دخانٌ طفيف. أزحت الأحجار، وكأنني أبحث عن الموت فرأيته. كانت أختي شيرين وقد أضحت كومةً متفحمةً. بالكاد عرفتها من شكل أسنانها الأمامية. أخرجتها وقلبي ما يزال ينتظر الاستيقاظ من الكابوس. صرخَ أحدهم من الجهة الأخرى أنه عثرَ على جثة ابن أخي عبد الكريم تحت الركام. لم أشعر بعلوِّ صوت العويل والإسعاف الذي ينتشل جثث عائلتنا وأقربائي والجيران. كأنني كنتُ في حضرة الموت الذي أسكت الضجيج في أذني. أخذني آخر لمساعدته في انتشال جثة، وإذ هي جثة ابنة أخي ريم. نُقِلوا جميعًا إلى المشفى. يبدو أن الموت كان على عجل. بحثتُ عن بقية أفراد عائلتي وأبي بين الخراب دون جدوى، توجهت إلى مشفى الرحمة فعلمتُ أن زوجة أخي عبير أيضًا قد فارقت الحياة. أحسست أن الردى سيلفّ كلّ من بقي حيًا. نقلوا جميعًا إلى الجامع وبعدها للدفن، وبدأت مأساة حزني من لحظتها حتى الآن. رنَّ هاتفي وارتجف جسدي كأنني سقطت من علو. شعرتُ بخبرٍ مفجعٍ آخر، أخبروني أن أبي في المشفى الوطني. دخلتُ وفزعُ موت أحدهم يسرِّع خطاي. لم يكن أبي، أخبرني أولاد عمومتي أن الجثة كانت عائدة لزوجتي الحامل بتؤام. عرفتها من أساورها الذهبية المسودّة. علِمت أيضًا أن جثة ابني في براد مشفى آخر. هرعتُ على الفور نحو ذلك المشفى. أتذكر جيدًا رقم جثته، كان الرقم ٢٦. كان الدم نازفًا من أذنيه وأنفه. لم أبكِ ولم أصرخ. شعرتُ للحظةٍ أنني الميت، ورأيت جثتي في أجسادهم الجامدة. كلما كنتُ أعود من دفن أحدهم كنتُ أحمل عذاب يقين موتهم، وفي الوقت نفسه، أحملُ أمل انتهاء الكابوس المفزع. لقد خلَّف التفجير الذي تبنّاه داعش خمسين قتيلاً وعشرات الجرحى.
بحثنا عن أبي في المشافي وتحت الأنقاض دون أن نعثر على أثر له. كانت آلة الحفر تنتشل الجثث لليوم الثاني، أخبرتُ سائقها عن مواصفات أبي إن عثر عليه، وقد تكون مشوهة بالحريق. مشيتُ عدة خطوات وإذ به يناديني أنه عثر على جثة. كانت جثة أبي. أغمي عليّ وسقطتُ بلا حراك؛ يعجز خيالي الآن عن رسم جسده المترب والمشوّه بالدماء المتيبسة.
أحيانًا أتحسسُ جسدي مندهشًا وأتساءل: “هل حقًا أنا حيّ بعد كلِّ هذا الوجع، وهل تحوّلت عائلتي إلى أكوام من عظام؟”
كلّما تذكرتُ التفجير شعرتُ للحظاتٍ أنه حصل في الأمس. أتذكرُ لحظات ضحكاتنا على الشرفة، وذكريات جلسات الأقرباء وسهرات السمر التي كنا نحياها، والتي باتت تنحصر في لحظة التفجير، وكأنها تجمدت بذات الصورة؛ ملامحهم المحترقة الغارقة في الدماء. لا أعرف لماذا اختصرها الزمن في اللحظات الأخيرة والأليمة. لم يبق أيُّ أثر لهم عندي، حتى الصور احترقت. وكأن الانتحاري المجهول كان ظلامًا ابتلع التفاصيل معه. كنتُ أفكِّر أحيانًا أنه لو توفي أبي سأحتفظ بكل أغراضه لأعيش ذكرياته الهادئة كما لو أنه حي، لكن التفجير حال دون ذلك أيضًا.
أحسُّ أحيانًا أنهم أحياء حين أراهم في أحلامي. أعاتبُ أبي لأنه تركني وحيداً. كنا نتناول طعام الإفطار ونعيش الهدوء بتفاصيله اليومية دون أن يعكِّر صفوها سوء، فتفاجئنا بالتفجير الإرهابي الذي حوَّل حياتنا للحظاتٍ إلى حسرةٍ نعيشها ما حيينا. رحل أفراد عائلتي وولِد ألم فراقهم في داخلي وروحي، فالذكريات أحيانًا شكلٌ آخر من الألم، يبعثُ الفجع بذواتنا ويرحل بهدوء.