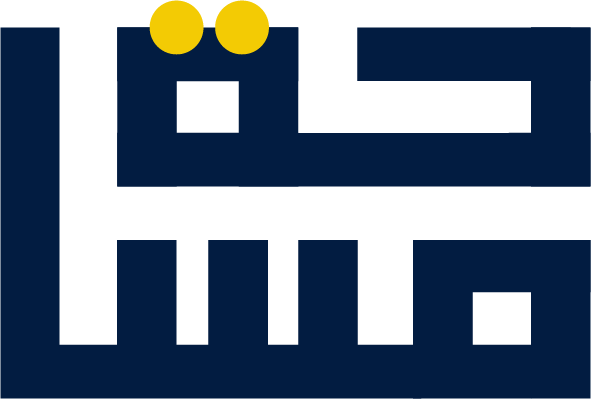مِنَ “الحُبِّ في الله” إلى السّبِي؟

وسطَ مِئات المُحتجّين الغاضبين من إقامة حفلاتٍ غنائيّة، حمَلَتْ سيّدةٌ عراقيّة لافتةً كُتِبَ عليها عبارة «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم» المأخوذة من آيةٍ قرآنيةٍ تُعدُّ مَرجِعًا للحركات الجهادية.
وجاءت هذه الاحتجاجات كصدىً لحملةٍ شنّتها شخصيات دينية وسياسية ضدَّ تنظيم فعاليات فنّية” تروّج للفُجور” على حدِّ تعبير رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وغير بعيدٍ عن العراق، سوف نجِد أحداثًا مشابهة. “قطع رؤوس دمى العرض في محلات الملابس النسائية الأفغانية”، “ضرب رجل دين إيراني لامرأة بسبب الحجاب”، “قرار مِن جامعة إدلب بمَنعِ اختلاط الذكور والإناث في وسائل التواصل الاجتماعي”.
تُوحي هذه الأحداث بعناوين وسياقات مختلفة لا رابط بينها (غناء، أزياء، تربية، تعليم، أخلاق). لكنَّ الواقع هو أنّها تتمحور حول موضوعٍ واحدٍ هو علاقة الإنسان المُسلِم بالجنس، وتَحكّم قوى معينة بمدى إشباعه لرغباته.
تحكّم وسيطرة
قد يكون تأثير وتجليّات الطاقة الجنسية في الحياة الإنسانية مِن أكثر الموضوعات التي شغلت علماء النفس والاجتماع في هذا المجال. وعلى الرغم من اجتهاد كثيرين لِنقد الفرويدية (أفكار سيغموند فرويد)، فإن ذلك لم يُغيّر من حقيقة مَركزيّة الدافع الجنسي، ودوره في صياغة السلوك البشري. وبالتالي فقد ظلَّت السّجالات مألوفةً إلى أن ظَهَرَ مفهومٌ جديد هو “الجنسانية”، وشكَّلَ نقلةً نوعيةً نظرًا لارتباطه بمسائل جوهرية منها “العدالة، والحقوق، والهوية، والتنوّع”. ويَعودُ للمفكِّر الفرنسي، ميشيل فوكو، فضلٌ كبيرٌ في تَتبّع هذا المفهوم تاريخيًا، ومن ثمّ تقديم إضافته الألمعيّة في سبعينات القرن الماضي والمتمثّلة بـ”السياسات الحيوية” المَعنيّة بالحياة الجسدية للفرد والسكان. ومعَ أنّ ما قدّمه “فوكو” بهذا الخصوص له سياق محدد يشمل تحليل أساليب وتقنيات الحكم في الغرب خلال قرون، وعلاقة السلطة بالمعرفة، وطُرُق هيمنتها على الطاقات والرغبات، فإنّ استخراج خيوط قليلة من هذه الأبحاث والكُتُب يفيد لِفَهم ما يجري في مجتمعات تخضع لسيطرة قوى إسلاموية كأفغانستان وإيران والعراق وشمالي سوريا، أو لِحكم أنظمة عسكرية ومَلكيّة تُساوِم شعوبها على احتياجاتها النفسية والمادية، وتُوهِمُها بمشاركتها في ممارسة السلطة، فتتركُ جَمعًا مهتاجًا على مواقع التواصل مثلًا يَبتُّ بحقِّ فتاةٍ في الرقص مِنْ عدمه!
“ما هو الإنتاج المطلوب من الفرد تحت حكم إسلاموي؟”
هواجس
لا يمكن وضع مجتمعاتنا بواقعها الحالي ضمن الخارطة التاريخية للجنسانية، بما أنها ما تزال تشهد صراعات بينَ قِيَم العفّة والطهارة، وموجات التبشير بثورة جنسية، وبما أنّ الحد الأدنى من الحقوق الفردية للإنسان هو مَحلّ تفاوض. وعلى هذا الأساس، تكفي مقاربة “استراتيجيات الإشراف على الجسد” بوصفها أداةً تُحقِّقُ للسُلطة أهدافًا أبرزها: زيادة الإنتاجية الاقتصادية للإنسان.
ولتطبيق هذه المقاربة لا بُدَّ من التساؤل: “ما هو الإنتاج المطلوب من الفرد تحت حكم إسلاموي؟” وللإجابة على السؤال ينبغي العودة إلى تصريح لرجل الدين والقيادي السابق في الحشد الشعبي، أوس الخفاجي، الذي هاجم مَن وصفهم بـ”الإسلامويين” على خلفيّة الاحتجاجات ضد الحفلات في بغداد (!) وفيما أقرَّ بـ”حرمة الغناء”، رأى “الخفاجي” أن الأولويّة ينبغي أن تكون لمحاربة المخدرات والدعارة!
هنا لا داعي لرصد الحِسِّ الفكاهي في تصريحاتٍ يُزايد بها الأصوليون على بعضهم البعض، ويُوحون بالتعددية والتنوير. فالأهمّ هو أنّ الشيخ أشارَ دون قصد إلى هاجس بلوغ المتع كمادة أوليّة لصنع مُجاهدين تتنازعهم هلاوِس الفضيلة واللذّة، وتتحكّم بعقولهم فتاوى التحليل والتحريم، وطموحات الحصول على امتيازاتٍ نتيجة وَلائِهم لشيخٍ أو قائد ميلشيا أو حزب.
ثنائيات وبدائل
يُجادل أنصار الحكم الإسلامي بأن الإسلام ليس استثناءً بين الأديان التي تُنظِّم حياة الفرد الجنسية، وتضَعُ لها قيودًا شرعيّة. غير أنه بالابتعاد عن المجاملات ستَسهُل رؤية المشهد بلا رتوش، بما يقود للإقرار بطبيعة التراث الإسلامي ليس كمُعطى نظري معزول، وإنما كمادة تدخل في التركيبة النفسية للمجتمعات المسلمة. ولعلَّ من سِمات هذا التراث أنه يبني التفكير على قاعدة “ممنوع، مرغوب” تجاه كلِّ أشكال الانجذاب الجمالي والعاطفي والغريزي. ولا يتعلّق ذلك بالموقف المُترفِّع عن “ملذّات عابرة في حياةٍ فانية” وحسب، بل أيضًا بخلفية ثقافية تضبط الحواس عمومًا، وتطالُ بالتحريم أنماطًا من النحت والرسم والتصوير. وهي ذهنية تخلَّص منها مسلمون كُثر ركِبوا قطار الحداثة، فيما بقي الجميع عمليًا أسرى الخوف من “منافسة إبداع الخالق”.
وتؤدي فكرة الثنائيات دورًا آخر بإيجاد بدائل نفسية، فتَجعَلُ مثلًا من تخيّلات شابٍّ لنساء الجنّة بديلًا له عن ضعف إشباعه الجنسي الدنيوي. ولدى البحث عن جذورٍ تربويّة لهذهِ التصوّرات، يصبح مِنَ المنطق إرجاع جزءٍ منها إلى “اتساع دائرة تابو المحارم”، وهو ما يَحدث حينَما “يؤدّي احترام شابّ لامرأة إلى تحويلها لصُورة مُتخيّلة عن أمه وأخته، فتتعطّل وظائفه الجنسية، ويَقترِن الإشباع لديه عندها باحتقاره للمرأة التي يُقيم علاقة معها” بحسب المُحلل النفسي الأمريكي ثيودور رايك.

يُجادل أنصار الحكم الإسلامي بأن الإسلام ليس استثناءً بين الأديان التي تُنظِّم حياة الفرد الجنسية، وتضَعُ لها قيودًا شرعيّة.

لكنْ هل يَصِحُّ نَسبُ هذه الظواهر إلى مجتمعٍ معيّن؟ بالتأكيد لا، فانتشارها مُحتَمل في أوساط إسلامية ومسيحية ويهودية وعلمانية. ويبقى الأخطر هو استغلال الشخص المعطوب نفسيًا مِن قبل أصحاب المشاريع الجهادية.
السعادة المبتورة طريقٌ للجهاد
قد يتراءى للبعض أن إيراد هذه المعطيات الفكرية يَهدُف إلى تجريم الإسلام، وتبرئة جِهات ما من تَوَرّطها في صناعة الإرهاب. ويمثّل هذا الانطباع إحدى غايات القوى السلطوية الدينية، إذ تحمي نفسها بإيهام جماهير المؤمنين بأنها مستهدفة دون سواها، وبأنّ دينها (نظريةً وممارسةً وعادات) لا تشوبه شائبة، وبأنّ من يُلقون الضوء على أسباب الخراب والتخلّف هدفهم شيطنة العقيدة!
وبعيدًا عن تصدير الأوهام، تَعِي هذه القوى أن وجودها مَرهونٌ بتخدير البسطاء بالأمل بعوالم أخرويّة سعيدة، وتُدرِك أيضًا أنّ رصيدها يكبُر عند الاستثمار في ضعف النفس البشرية. وعليه يَغدو تخويف الناس من مظاهر الفرح والجمال ضرورةً لبقاء وثراء المشايخ والميليشيات وشبكات المصالح المحيطة بها، فهؤلاء يراهنون على أن ينطلق تأسيس “جيش المهدي” وفصائل “تحرير الشام” من لحظة كبت المُسلِم لتعبيراته عن الحبِّ والودّ، ووَضعِه لحاجزٍ يَحميه من “احتمالات الوقوع في الخطيئة” عنوانُه: “أحبُّكَ في الله يا أخي/أختي، يا صديقي/صديقتي…”