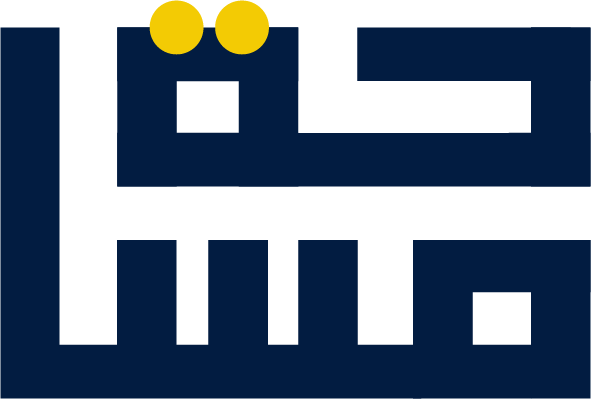مِن “تفاهمات الموصل” إلى مَقتَل الخَليفَتَيْن: “داعش” و”الجهاد السوري” في رعاية الاستثمار التركيّ

(1/3)
بدرخان علي
كاتب كردي سوري
أعادَ مقتل خليفة الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ”داعش”، عبدالله قرداش، المعروف بـ”أبو إبراهيم القرشي”، في عملية أمريكية خاصّة ضدَّ مخبئِه السرّي على الحدود التركية-السورية، قريبًا من مكان مقتل سَلَفِه أبو بكر البغدادي، تسليطَ الأضواء على استراتيجية القيادة التركية حيال تنظيم “داعش” وماهيّة العلاقة بين الجانبين.
ثمّة سؤال يخطر للمرء في أعقاب الحادثتين المختلفتين في التوقيت:
لماذا لم تأسِر (أو تقتل) الحكومة التركية بنفسها الخليفة قرداش، وقبله البغدادي، وبينهما سامي جاسم الجبوري، المشرف المالي لـ”داعش” ونائب أبو بكر البغدادي الذي ساهمت الاستخبارات التركية في اعتقاله وتسليمه للحكومة العراقية من المنطقة نفسها التي كان يختبأ فيها البغدادي وقرداش وغيرهما من كبار الجهاديين، وهم يقطنون في أماكن تحت ظلال احتلالها في شمالي سوريا، وبالقرب من مواقعها العسكرية تمامًا و أمام أنظارها وفي متناول أياديها وأيادي عملائها السورييّن. ولماذا تترك أنقرة هؤلاء القادة الكبار صيدًا ثمينًا لواشنطن، ولا تقوم هي باصطيادهم لتكسب سمعة “محاربة داعش” خصوصًا أنها معروفة بتعاونها مع داعش وتمتلك سمعة سيئة في هذا المجال عالميًا؟
بالطبع، يأتي طرح مثل هذا التساؤل من منطلق عملي بحت، وهو استحالة عدم معرفة الجانب التركي بحيثيّات الغارة الأمريكية زمكانيًا؛ فالمنطقة المُستهدَفة تقع تحت احتلال تركيا ولها تواجدٌ عسكريٌّ واستخباراتيٌّ وإداريٌّ هناك من جهة، وهي على مرمى حجرٍ من الحدود التركية، وفي الجو هناك طائرات تركية، وأحيانًا روسية، من جهة أخرى. فمن البديهي أن تُعلِمَ الولايات المتحدة حليفتها تركيا (وغريمتها روسيا كذلك عن طريق قنوات التواصل العسكرية بين الجانبين في سوريا) بالجوانب العملياتيّة للغارة الأمريكية تفاديًا لأيّ حوادث تصادم في الجو أو على الأرض.

لماذا لم تأسِر (أو تقتل) الحكومة التركية بنفسها الخليفة قرداش، وقبله البغدادي، وبينهما سامي جاسم الجبوري، المشرف المالي لـ”داعش” ونائب أبو بكر البغدادي

أما المنطلق الثاني فهو: رغم الاستثمار التركي الهائل في هذا “الغول” الذي اجتاح العراق وسوريا، لا يَعتَبِرُ كاتب هذه الأسطر الدولةَ الإسلامية في العراق والشام (داعش)، صَنيعةَ تركيا، ولا صنيعة جهةٍ أخرى. فالدولة الإسلامية، التي يُطلِقُ عليها خصومها تسميةً باتت شائعةً و حَملت دلالاتٍ تحقيريّة مع الوقت، (داعش)، هي قبل كلِّ شيء حركة اجتماعية تغييرية بالِغة الثوريّة والجذريّة (الراديكالية) والتطرّف، وإحدى التنظيمات المستقلّة و “ذات السيادة” النادرة جدًا في المنطقة، وخصوصًا في سوريا، وثمرة كفاح مرير وصبر مديد وتضحيات باهظة تكبّدها جهاديّون من بلدانٍ إسلاميةٍ شتّى في “ساحات رباط” عديدة قبل الظفر بدولة إسلامية، ذاك الحلم الذي راودَ أجيالًا من الجهاديّة الإسلامية في العقود الأربعة الأخيرة، بمشاربهم وتجاربهم العمليّة متعددة الساحات، امتزجت كلّها في ميدان “الجهاد العالمي” في أفغانستان ثم تحوَّلَ إلى العراق المُنهار بعد محطاتٍ عديدةٍ حيث أُضيف تيارٌ محلّيٌّ غزير ممتلئ بالعنف الطائفي الدمويَ رافدًا لموجة الجهاد الأممي الذي صارَ العراق أرضًا له بعد إسقاط نظام صدام حسين وانهيار الدولة العراقية والاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني بوجهه المذهبيّ الفاقع، فتطبّعت الجهادية الإسلاميّة بملامح عراقية، كان من علاماتها المستجدّة “وحدة حال” جمعت بين جهاديين سلفييّن مع متدينيين مُحافظين غير جهاديين مع ضباطٍ قوميين من نظام صدام حسين ذي الخلفية غير الدينيّة، وإن كانَ غير علماني وانتهازي في هذا المجال خصوصًا في سنواته الأخيرة، إذ كانت الطائفيّة ومعاداة الشيعة وإيران والنظام العراقي الجديد بعد 2003 بالدرجة الأولى، وكذلك الكرد والأقلّيات الدينيّة، هي الأرضية والقُطبَة التي جمعت كلَّ هؤلاء في تنظيمٍ واحد. حتى في إلحاح القيادة العراقية على إعلان الدولة كانَ ثمّة بعدٌ عراقيٌّ محلّيٌّ قوي، وردُ اعتبارٍ للسنّة العرب (والتركمان) بالضدِّ من الهيمنة الشيعية الإيرانيّة على “العراق العربي” و”دولة الأمر الواقع” في كردستان، الأمر الذي كان محلَّ خلافٍ كبيرٍ بين القيادة المحليّة للجهاد العراقي والقيادة المركزية للقاعدة، إذ لم تستطع الأخيرة استيعاب التطلّب على الدولة من قبل الفرع العراقي الذي توسَّعَ باتجاه الأراضي السورية المجاورة مستغلًّا الفوضى وضعف السلطة فيها بعد الحرب السورية و ضمِّها لدولة الخلافة لتشكيل (إقليم قاعدة)، أي دولة للسنّة في الدولتين (يطابق تاريخيًا القسمين السوري والعراقي من إقليم الجزيرة الفراتية) لمجابهة (العدو القريب) أولًا، أي الشيعة في العراق والعلويين في سوريا، فيما كان طموح واستراتيجية القاعدة الأم لا يتعدّيان كيانات صغيرة منعزلة وفق نموذج الإمارة/أمير المؤمنين/الإمارات (لا الدولة-الخلافة/الخليفة/الولايات) في أفغانستان أساسًا، وباقي الفروع في المنطقة العربية. ولا يمكن لمراقبٍ يتحلّى بأدنى قدر من الواقعيّة أن يُنكر جدوى تكتيكات الدولة الإسلامية العسكرية -الإرهابية الدمويّة- من حيث القدرة على ترويع الخصوم والأعداء والمنافسين وترهيبهم، ونموذجها العنيف الصارخ في “بناء الدولة” وإخلاص أعضائها وأنصارها وتضحياتهم الباهظة وسط مجموعة كبيرة من الأعداء. يستغربُ المرء بالفعل حين يسمعُ تسمية “مرتزقة داعش”، في بعض وسائل الإعلام الكرديّة على سبيل المثال، وإعلام “قسد” الرسمي خصوصًا، فـ”الدواعش” ليسوا مرتزقة، لا لأردوغان ولا لسواه.
استثمارٌ ومهادنة وجيرةٌ طيّبة!
إنّ الوقوف على أوجه التعاون بين أجهزة الدولة التركية والدولة الإسلامية بالتفصيل يحتاجُ إلى استعادة أرشيفٍ ضخمٍ من الوثائق المُسرّبة والتقارير المؤكدة فضلًا عن سلسلة الوقائع والمجريات المترابطة والقرائن الدالّة، وسنكتفي هنا ببعض أبرز العناوين:
من سياسة الباب المفتوح مع الجهاديين من حول العالم الذين التحقوا بداعش وغيرها من التنظيمات الجهادية عبر المطارات التركية ثمّ إلى سوريا، ومعالجة جرحى “داعش” في المشافي التركية، والإفراج عن أخطر الجهاديين المُدانين في السجون التركية، والسماح لهم بحرية التحرّك داخل تركيا وإلى سوريا، إلى وثائق “ويكليكس” حول تجارة النفط بين داعش وتركيا، عبر صهر الرئيس التركي ووزير طاقة دولته، بيرات ألبيرق، مرورًا بالوثائق التي عثرت عليها القوات الأمريكية في منزل “وزير نفط داعش”، أبو سيّاف، في دير الزور السورية، إلى الوثائق التي سرَّبها موقع “نورديك مونيتور/Nordic Monitor” السويدي من أروقة الاستخبارات والمحاكم التركية، والتي تثبتُ عِلم أجهزة المخابرات التركية بتحرّكات مقاتلي داعش، بما فيها علمها بالتفجير الإرهابي الكبير الذي ضربَ مدينة قامشلي السورية 2016 قبل وقوعه، وتحرّكات مقاتلي داعش داخل وخارج تركيا، وحصول مقاتلي داعش والقاعدة في سوريا على مكوّنات غاز السارين من الاستخبارات التركية، وتمرير الأسلحة إلى الجهاديين في سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية ودور المنظمات “الخيرية” التركية في ذلك، واستخدام البنوك التركية في تحويل الأموال لمقاتلي داعش والقاعدة. وبينما كانت الدولة الإسلامية تحتلُّ مساحات واسعة من الأراضي السورية على الحدود التركية مباشرةً، التزمت الحكومة التركية بمبدأ حسن الجوار التام معها، وسمحت بمرور قوافل المقاتلين الجهاديين أمام أنظارها إلى شمالي سوريا من سري كانيه (رأس العين) إلى كوباني و تل أبيض والرقة، ومنبج و جرابلس وإعزاز والباب.
إنّ الوقوف على أوجه التعاون بين أجهزة الدولة التركية والدولة الإسلامية بالتفصيل يحتاجُ إلى استعادة أرشيفٍ ضخمٍ من الوثائق المُسرّبة والتقارير المؤكدة فضلًا عن سلسلة الوقائع والمجريات المترابطة والقرائن الدالّة
الموصل: داعش وتركيا و”أزمة الرهائن” الأتراك
هناك حادثتان تأسيسيّتان ذات دلالةً خاصةً في سياق “العلاقة التخادمية” بين الحكومة التركية و”داعش” تستحقان الإضاءة عليهما.
اقترحُ أن نقطة البداية في هندسة العلاقة بين أجهزة الاستخبارات التركية والدولة الإسلامية تعود إلى لحظة سقوط مدينة الموصل العراقية في قبضة الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2014، من دون أن نُغفِلَ علاقات أجهزة الدولة التركية الطويلة مع الجماعات الطائفية السنيّة أو القوميّة التركمانيّة في العراق. تلك اللحظة التي لم تكن انطلاقةً جديدةً وحسب في مسيرة دولة الخلافة الإسلامية واشتداد عودها وتوسّعها الجغرافي (مرحلة “شوكة التمكين-قيام الدولة” بعد مرحلة “شوكة النكاية والإنهاك” أولًا ومرحلة “إدارة التوحّش” ثانيًا، بلغة كتاب “إدارة التوحّش” لمنظِّر جهادي كبير نُشِر باسمٍ وهمي “أبو بكر الناجي”)، بل كذلك لحظة صياغة تفاهمات بين الدولة الإسلامية والمسؤولين الأتراك في خضمِّ “أزمة الرهائن” الأتراك المحتجزين لدى داعش، الغامضة، أو ما نسميها بـ”تفاهمات الموصل”.
ففي تقرير لجنة التحقيق النيابية العراقية المكلّفة بالتحقيق في سقوط الموصل (لجنة الموصل)، والتي وجّهت اتهامات لعدد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلّحة بالمسؤولية التقصيرية، يَرِدُ عن دور القنصل التركي في الموصل ما يلي: “الدور الدولي: دور القنصل التركي في محافظة نينوى وعلاقته مع عصابات داعش الإرهابية، وقيام المحافظ (أثيل النجيفي) ومدير مكتب جهاز المخابرات في المحافظة (ناجي حميد)، بالتستّر على دور القنصل هناك، وعلى جهاز المخابرات الوطني العراقي التحقق من المعلومات الواردة في هذا الملف واتخاذ إجراءاتهم المناسبة وفقًا للقانون وخططهم المخابراتية وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية.” وأضافَ رئيس لجنة التحقيق في تصريحاتٍ إعلامية: “دور القنصل التركي في الموصل كان مشبوهًا وحركته كانت غير طبيعية بعد تجاوزه الأطر الدبلوماسية لأنه أدارَ الكثير من الأمور وكأنه محافظ نينوى”.
وبيَّنَ أنه “بعد سقوط الموصل، جاءَ مسؤول الحماية على القنصلية التركية وأبلغهم بدخول داعش فكان ردُّ القنصل: اذهب وشأنك نحن نعرفُ كيف نتصرف”، مشيرًا إلى أن “القنصلية رفضت الخروج من الموصل وأبقت على موظفيها طيلة /11/ يومًا بعد دخول داعش”. ويشدّد رئيس لجنة الموصل على أنَ “كلَّ هذه الخروقات مثبتة في تقرير اللجنة، الأمر الذي دفعنا لإدراج اسم القنصل ضمن قائمة المقصّرين.”[1]
فور سقوط الموصل في قبضة دولة الخلافة في حزيران/يونيو 2014، احتجزَ العناصرُ رهائن أتراك بلغَ عددهم /49/ رهينة، من بينهم القنصل العام التركي في الموصل وعائلته وعناصر من القوات الخاصة التركية، وعددًا من سائقي شاحنات أتراك كانوا قد احتُجِزوا في الموصل أيضًا. أُفرِجَ عن جميع هؤلاء، وهم بصحة جيّدة، في الوقت الذي لم يحظى أيُّ أسيرٍ من أيّ جنسية أو قومية أو دين أو مذهب بهذه المعاملة من جانب “داعش”، التي غالبًا ما كانت تقطع رؤوس الأسرى وتنشرُ تلك المشاهد المفزِعة على الملأ لبثِّ الرعبِ في قلوب الناس، إن لم يحصل عناصر التنظيم على الفديات المالية المطلوبة، والتي غالبًا ما تكون مبالغ مالية باهظة، وخصوصًا إذا ما كانوا رعايا دول أجنبية، إذ كانت تشكِّلُ مدخولًا للتنظيم وبندًا أساسيًا في ميزانيته. نفى المسؤولون الأتراك دفع أيّ فدية مقابل الإفراج عن الأسرى، واكتفوا بالقول إنها كانت عملية ناجحة للاستخبارات التركية. إلا أن الشكوك كانت كبيرة منذ البداية وتوقَّعَ عددٌ من المراقبين حينها أنَّ صفقةً ما قد عُقِدت بين الجانبين، التركي والداعشي، وهذا ما رجّحتهُ الأيام التالية.
تكرَّرَ هذا التعامل الداعشي الخاص مع ما يتّصلُ بمصالح تركيا في عدم المساس بضريحٍ يُنسَبُ لـ”سليمان شاه”، جدُّ عثمان الأول، مؤسّس الدولة العثمانية، يقعُ داخل الأراضي السورية قرب مدينة منبج على نهر الفرات ويخضع للسيادة التركية، رغم أن الضريح “يستوفي” كافة موجبات الهدم وفق عقيدة “داعش” التي لم توفِّر ضريحًا أو مزارًا دينيًا في أيّ منطقة سيطرت عليها في العراق وسوريا إلاّ وهدمته؛ فالقبور البارزة عن الأرض (أكثر من شبر) والمقامات والأضرحة والمزارات، بدعةٌ محرّمةٌ ومِن وسائل الشِرك بالله عند جمهور علماء السلفيّة، وهدمها مسألةٌ مبدئيةٌ غير قابلة للنقاش وتحوزُ أهميةً خاصةً في الخطابات والسجالات لديهم. وعلى جري عادتهم وتعاليمهم وممارستهم و”عفويتهم”، هدَّدَ عناصر داعش في الأيام الأولى بتدمير الضريح الكبير المزيّن بالأعلام التركية والكتابات، لكن لم يفعلوا طيلة أكثر من ثمانية أشهر حتى قيام الحكومة التركية بتسيير عملية عسكرية خاصة لنقل الضريح من هناك بتاريخ /22/ شباط/فبراير 2015، وبتعاونٍ كاملٍ مع عناصر “داعش”. ولا تفسير لهذا السلوك سوى براغماتية الخليّة الأمنيّة في قيادة “داعش” إزاء كلِّ ما يخصُّ تركيا، بناءً على التفاهمات المعقودة بين الجانبين.
بعد سقوط الموصل، جاءَ مسؤول الحماية على القنصلية التركية وأبلغهم بدخول داعش فكان ردُّ القنصل: اذهب وشأنك نحن نعرفُ كيف نتصرف”، مشيرًا إلى أن “القنصلية رفضت الخروج من الموصل وأبقت على موظفيها طيلة /11/ يومًا بعد دخول داعش”. ويشدّد رئيس لجنة الموصل على أنَ “كلَّ هذه الخروقات مثبتة في تقرير اللجنة، الأمر الذي دفعنا لإدراج اسم القنصل ضمن قائمة المقصّرين
ووفقاً للباحث والمحلّل الأمني العراقي، هشام الهاشمي، الذي درس “عالم داعش” من الداخل بدقة ومسيرة التنظيم وقياداته وخلفيّاتهم، فإن الخليفة البغدادي كان “منزعجًا من التفاهم مع الترك”[2]، ما يرجِّحُ لدينا أن يكون وراء هذا التفاهم رؤوس كبار في التنظيم غير البغدادي الذي لم يكن له دراية بمدينة الموصل أو تجربة فيها، فهو ابن سامراء وقضى شبابه وتعليمه و”جهاده” في بغداد. وبحسب مصادر عديدة فإن البغدادي كان يعتمدُ على “حلقة تلعفر التركمانية”[3] في إدارة الشؤون الأمنية (وتعرّفَ كذلك بالقرادشة، وهي جمع لكلمة “قرداش” التي تعني بالتركية “الأخ”). فالموصل وريفها منطقة نشاط المجموعة و”جهادها”، و”عبدالله قرداش” من تلك المجموعة المعروفة بشراستها وعنفها، وكان رجل “الدولة الإسلامية” الأول في الموصل قبل إعلان الخلافة وبعدها والمسؤول الأمني والشرعي ومسؤول دواوين الخلافة كافةً، بل هو الذي رحَّبَ بالبغدادي في الموصل، وربّما هو الذي اختار البغدادي لمنصب الخلافة. وأصبحَ لاحقًا مسؤولًا عن المناطق السوريّة المحتلّة من قبل داعش، وثمة تقارير تقول إنه كان المفاوض مع الحكومة التركية في ملفِّ الأسرى الأتراك ورافقهم من الموصل وحتى تسليمهم للمسؤولين الأتراك عبر الأراضي السورية. وهناك تقديرات تفيدُ بأن “حلقة تلعفر التركمانية” كانت وراء الهجوم على بلدة كوباني الكردية السورية.
يتبع…
[1] – وفي السياق ذاته، يقول النائب إنّ “التقرير تمَّت إحالته الى القضاء وسيتمُّ اتخاذ القرارات المناسبة لمساءلة المقصِّرين في الفترات المقبلة بعد دراسته من قبل القضاء بشكلٍ مستفيض”.
وأضاف الشمّري، في تصريحٍ لـ(المدى)، أن “القضايا التي سيفتحُ القضاء التحقيق بشأنها تشملُ سقوط مدينة الموصل والمتسببين بذلك فضلًا عن مشاكل الفساد التي سبقت دخول داعش الى المدينة”.
وعن أسباب إدراج اسم القنصل التركي ضمن قائمة المتهمين، يقول النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمّري، عضو اللجنة التحقيقية، إن “رئيس جهاز المخابرات في محافظة نينوى أدلى بشهادته أمام اللجنة مؤكدًا أن القنصل التركي هو محافظ نينوى وليس أثيل النجيفي، وإن القنصل التركي كان يقوم بزيارة بعض الشخصيات المشبوهة وصاحبة القرار الأساس”.
لكنَّ الشمّري يستدركُ بالقول: “كان من الصعب استدعاء القنصل التركي إلى اللجنة التحقيقية لأن ذلك يتطلَّبُ تدخُّل وزارتي الخارجية التركية والعراقية وموافقة الدولة التركية”، في إشارةٍ إلى الاعتبارات الدبلوماسية فضلًا عن توتر العلاقة بين بغداد وأنقرة. (التقرير والتصريحات أعلاه متوفرة على شبكة الإنترنت).
المصدر: لجنة الموصل: القنصل التركي كان بمثابة المحافظ الفعلي لنينوى.. والاعتبارات الدبلوماسية منعت استجوابه. صحيفة المدى (العراقية)، العدد /3435/، تاريخ 2015/08/20
[2]. هشام الهاشمي، عالم داعش، دار الحكمة، لندن-بغداد، الطبعة الأولى 2015. ص: 271
[3]. حول “حلقة تلعفر التركمانية” يُنظَر إلى:
– حسن أبو هنية، البناء الهيكلي لتنظيم “الدولة الإسلامية”، مركز الجزيرة للدراسات، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
الرابط التالي: https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112363816513973.html
– د. آزاد أحمد علي، داعش كحلقة رئيسية في النهج المعادي للكـورد.
* جريدة الوحـدة، العدد /311/، آب/أغسطس 2019، الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
الرابط التالي:
https://yek-dem.net/ar/?p=10228
المقال يعبّر عن رأي الكاتب